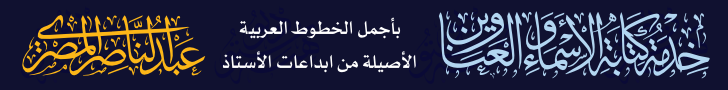يبقى الخط العربي بالرغم من كل التطور في أدوات الكتابة ووسائل التكنولوجيا واحداً من أهم روافد المعرفة الفنية.
يبقى الخط العربي بالرغم من كل التطور في أدوات الكتابة ووسائل التكنولوجيا واحداً من أهم روافد المعرفة الفنية.
أليس هو ذلك الرسم والشكل الحرفي ذا الدلالة في الكلمات المنطوقة أو المسموعة؟ “فسوسير” (عالم اللغويات الفرنسي) يرى أن: “اللغة والكتابة نظامان متميزان من الإشارات (العلامات)، والهدف الوحيد الذي يسوغ وجود الكتابة هو التعبير عن اللغة. لكن الهدف من علم اللغة، ليس الصورة الكتابية والصورة المنظومة للكلمات، بيد أن الشكل المنطوق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصورة المكتوبة، التي تطغى على الصورة الأولى (الكلمة المنطوقة)، فيهتم الناس بالصورة المكتوبة للإشارة الصوتية أكثر من اهتمامهم بالإشارة نفسها. وشبيه هذا الخطأ اعتقادنا أننا نستطيع أن نميز الشخص من الشخص الآخر من خلال صورته أكثر من النظر إليه مباشرة”.
ولعل البدايات الأولى للكتابة العربية والعودة إلى جذورها وأصلها ومدى تطورها، وصورة ذيوعها وتداولها بين الناس، لا يشكل حجر الزاوية بالنسبة لنا. لكن من البديهي إلقاء نظرة سريعة على التطور الذي مس جانباً مهماً من هذا الفن المشرق.
تشير كثير من الدراسات إلى أن العربي في العصر الجاهلي، كان يعرف الكتابة، وإن لم يستخدمها إلا في الأغراض السياسية والتجارية. أما الحاسة الجمالية، فلم تكن مهمّشة أو مغيّبة، بل عرفت مبكرًا. ويكفينا فخرًا أن الرؤية الانطباعية الأولى التي قدمتها “أم جندب” كأول ارتسام عربي نقدي جمالي حين قارنت بين “امرئ القيس” و”علقمة” في قول الشعر، ففصلت بين الجيد والرديء، وبين الجميل وما دونه. إنها النواة الأساس العربية التي يؤطرها الذوق الفني الذي يؤسس لعلم الجمال الذي سيحفل به التاريخ من خلال أسواق الشعر كعكاظ والمربد.
أما المجهودات التي قام بها كل من صانعي قرار الرواية، ومقدمي الطبقات والموازنات والجمهرات، فهي بحق مساهمة فعالة دون انفعال. وجب أن نقر أنها ارتسامات منبعها التربة الجميلة التي لا تنبت إلا الجمال.
الكلمات الأولى
حين جاء الإسلام، كانت أول كلمة ربانية نزلت على الرسول -صلى الله عليه وسلم- هي: {اقرأ باسم ربك الذي خلق}. وفعل القراءة فعل ماكر، إنه العملة ذات الوجهين، إذ لا يمكن القيام بالقراءة إلا من خلال فك رموز الشفرة المرسومة كتابة أو رسماً أو لوناً. ولهذا كانت متواليات الآيات تزيد من الإفصاح والتوضيح: {اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم}. ففعل القراءة/التعلم رهين بالقلم، وما القلم إلا وسيلة، وما الوسيلة إلا ضرورة للكتابة.
يقول ابن خلدون: “الخط رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس، فهو ثاني رتبة من الدلالة اللغوية وهو صناعة شريفة، إذ الكتابة من خواص الإنسان التي يميز بها عن الحيوان…”.
وبهذا واصلت الكتابة العربية تحوّلها إلى ظاهرة حضارية، وبات الناس يؤمنون بشيء واحد هو أن الكتابة قيد العلم. إن البداية التي شغلت المبدع/ الخطاط العربي، تجلت في تعامله مع المفاهيم الأولية لطرح الإشكالية وخلق البديل، وتجاوز النمط التقليدي دون الإخلال بالجوهر، وأمسى من البديهي أن ينظر إلى ما حوله، وأن يربط علاقة حميمة بين الكائن/الإنسان وباقي الموجودات، ويتعرف ويقوم بمعادلات. حينئذ انبثق ذوق رفيع جعل الحرف يخرج من النقلة الشكلية إلى مراعاة الدقة والنسبة والوزن والحجم والشكل، فتحقق التطور بمعناه الانتقالي الذي تطور من الحركة الساكنة إلى الفعل المتحرك.
لقد كان ثاني مجال استيطيقي اهتم به العربي المسلم بعد الشعر هو الكتابة، بحكم أنها مشروع، مادام أن كل ما ينزل على الرسول من وحي يستدعي الكتابة، ولهذه المهمة النبيلة تكلف رجال أكفاء أصحاب باع في هذا الميدان – كتاب الوحي – وكان من جملتهم الخلفاء الراشدون وثلة من الصحابة.
إن التراكمات الكتابية الخطية التي سجلها الناسخ المبدع على مر التاريخ بمختلف الطرق ومختلف الأدوات، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن جوهر هذا الفنان اتجه نحو الإنتاجية الإبداعية ذات الأبعاد الدينية والفلسفية والثقافية، وهو ما جعل مناخات روح الإسلام بكل تجلياتها تهيمن على هذا الفن.
وقد تسلل الخط تدريجيًا كعنصر ضروري للحياة، فدخل مزهواً للبيوت، وجال رحاب المساجد والمدارس ودواوين الأمراء والوزراء، فوثق وألف ونسخ، حتى أصبحت الحاجة ماسة إليه، وغدا من الضروريات الملحة والأكيدة.
هكذا امتد هذا العشق ليتحول إلى هيام لدرجة العبادة، فجعله المتتبعون واسطة العقد، وعدوا عاشقه مبدعًا وموشيًا ومطرزًا، فانطلق فاتحًا وأستاذًا إلى كل الدول والأمصار، متعايشًا مع الزمان والمكان والطبيعة والمخلوقات. فهو رد فعل لعبادة الأصنام، حين أراد الفنان الإسلامي أن يسخّر فنه وإبداعه للدين الجديد – الإسلام – أن يعطي للخالق قدسيته.
فن الحضارة
يشير “ابن خلدون” إلى أن الخط من الصناعات الإنسانية يقوى بقوة الحضارة، ويضعف بضعفها. أما (توماس و. أرنولد) فيضيف: “أما الفن الذي كان المسلمون أنفسهم يضفون عليه قيمة عليا فهو فن الخط، فهم كانوا فخورين بتعهدهم هذا الفن وصقله له بأنفسهم، وأنهم لم يتلمسوا فيه العون من فنانين أجانب …”.
إن الإيقاع الانسيابي بين ذات المبدع، وتمظهرات بصمات يده على صفحة البياض لهو أسمى وميض للجمالية. إنه معنى من معاني عظمة الخالق، إذ شرف الإنسان باليد التي تمسك بالقلم، وتبصم على الفراغ جمالاً. إن الخط بالنسبة للفنان العربي ممارسة عبادة، إذ بواسطته تكتمل المعجزة في نقل كلام الله إلى أفئدة المؤمنين. ” إنه عبادة، أسلوب صوفي خاص يتميز بالانفراد والتوحد والوجد والذوق كي يتم الإبداع”. ولقد حمل لنا التاريخ أسماء مجموعة من المتصوفة الذين أصابهم الانبهار بجلالة الحرف، فصاغوا رسائل ومؤلفات عن أسرار هذا الصامت الناطق، فكانت الشطحات المدونة لكل من الحسن البصري، ومحيي الدين بن عربي، ومالك بن دينار، ويحيى الصوفي وغيرهم إشراقات جميلة وجليلة، أضافت نكهة أخرى لا يتم سبر أغوارها إلا من طرف أهل البرهان والدليل. وكان بقدر ما يسعى الخطاط لممارسة عمله الفني ويبدع فيه، كانت له طقوس خاصة مصاحبة لهذه الممارسة، تتجلى في الطهارة التامة للخطاط، واختيار الزمان والمكان، واستقبال القبلة، وصلاة ركعتين، وتيمن، وتلاوة آيات خاصة قبل البدء وعند الختام، ثم من اختيار للأقلام، وبريها … وهذا لا يتحقق إلا لمن أسبغ الله عليه نعمته في خشوع وتحمل المسئولية، مادام الأمر يهدف إلى غرض نبيل، وفي الوقت نفسه، يسعى إلى الوصول إلى نوع من التطهير. فالكتابة تكون شبيهة بالشطح الصوفي، وشطحات الخط متعلقة بشطحات الوجدان الداخلي للخطاط. ولا يمكن إغفال ما لاسم الجلالة (الله) من حضور متميز. إنه نقطة النور التي يكون منها الانطلاق، وإليها الرجوع، إنها الهالة الكبرى التي يتجمع حولها بقية العباد، إنها النواة/ المركز/ الأساس.
أليست هي المحور وما تبقى يعد تأليفًا؟
الخطاط والصوفي
إننا لنجد بعض القواعد تضم تفردا، خاصة لاسم الجلالة (الله) واسم نبيه -صلى الله عليه وسلم-، كما يتجلى ذلك في بعض نماذج خط الثلث، والثلث الجلي. أليس هو {الله نور السموات والأرض…}. وبهذه الصورة يتم التشارك بين الخطاط والصوفي، ماداما يغرفان من نبع واحد. يقول “الكندي”: “ولا أعلم كتابة تحتمل من التجليل حروفها وتدقيقها ما تحتمّل الكتابة العربية”. أما المتكلم المعتزلي “النظام”، فيشير إلى أن : “الخط أصيل في الروح وإن ظهرت بحواس البدن”.
سبقت الإشارة إلى أن العربي عرف الكتابة في الجاهلية، لكنه استعملها باقتضاب لمجموعة من العوامل، وقد يكون على رأسها عدم توافر الوسائل: الورق، الحبر … ثم هيمنة سلطة الرواية. وجاء الإسلام ثورة على ما سبق، فغدا المسلم يستحضر الكتابة في جميع مناحي الحياة، وتحرر الحرف العربي من الاعتقال، إذ أصبح يساير الركب الإسلامي أينما حل وارتحل، فتسارعت مجهودات “أبي الأسود الدؤلي” ومن تبعه في إخراج الخط/ الحرف من الإبهام، والخوف من اللحن.
وفي ظل المعطيات الحداثية التي تشكل فيها الوعي الاجتماعي، وبرزت صلاته مع باقي المعطيات الأخرى (فلسفة، أخلاق، علوم…)، كان لزامًا على العربي أن يلتفت إلى رشاقة هذا المقدس، وأن يسكب عليه من الآيات الوراثية والجلالة حتى يكون في مستوى حمل كلام الله -عز وجل-.
وتسارعت مرة ثانية مجهودات مجموعة أخرى في إضفاء سمة التمييز، ضمن تعدد رهين بأن يصيب وحدة تشدد الجمال، فكانت رشاقة في الاتصال والانفصال، تساهم في بلورة مدارس جديدة بالغة الأهمية أضافت التجويد والحسن، وجعلت للحرف استحسانًا وكيانًا في صورته البصرية، كما تتردد صورته السمعية بالخفقان بين منتجه /الخطاط ومتذوقه/ المتلقي، فتألق نجم الخط العربي كمعلمة أساسية في تكوين الحضارة، “وحدث التطور الحاسم عند امتزاج الجوانب الجمالية لكل من الإيقاعيين الديناميكي والسكوني بامتزاج الشكل الهندسي (الزخرفي) بالشكل اللاهندسي (اللغوي). وبعبارة أخرى، بعد أن تنسم مبدأ التركيب صورة في وضوح المنظومة الشكلية للحرف والجميلة في الكتابة العربية، وهذا ما كان يمثله بالضبط إرساء الكتابة على أسس رياضية هندسية”.
وما لبثت وتيرة سيمفونية الخط العربي تتلاقح وتتكامل، وتظهر في رونق جذاب، وتنسج معالمها بمجموعة من النماذج التي أصبحت حجر الزاوية في المنظومة الجمالية لهذا الحسن وهي: الخط الكوفي، الخط النسخي، الخط الثلثي، الخط الرقعي، الخط الديواني، الخط الفارسي. وسرعان ما تفرعت أنواع عدة عن هذه الخطوط. وقد قام “مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض”، بحصر مائة وسبعة وثلاثين اسمًا من أسماء الخطوط موزعة إلى إحدى عشرة عائلة صنفية تعود إلى أسماء تنتسب إلى الأماكن أو الأشخاص أو الوظائف التي ينتسب إليها أصحاب الخطوط.
“أيها الفنُّ العظيمُ بتأثيره، الغريبُ بأعماله، السامي بجماله وأسراره. أنت شَبَحٌ من مقدرة المبدع الأزلي في نفوس النوابغ المبدعين، أنت فكرة مستيقظة في هذا العالم النائم بحراكه، الجامد في مسيره”. (جبران خليل جبران)
أنواع الخطوط
– النسخي: هو وليد التعامل اليومي المتسارع، يمتاز بالليونة والطواعية. استخدم في المصاحف والكتب، وقد اتخذته المطابع نموذجًا للكتابة قبل نماذج خطوط الكمبيوتر، إنه الأكثر سهولة للمبتدئين، وكان له الشرف إذ خط به زيد بن ثابت – رضي الله عنه – الوحي ثم القرآن الكريم. كما كان “لابن مقلة” الفضل الكبير في تطويره وإعطائه السمة العلمية الخاصة به.
– الثلث: هو أشهر الخطوط، كثير الانتشار بالرغم من صعوبة حروفه وتداخلها، يقبل ملء الفراغات بالتشكيل خصوصًا في الثلث الجلي. وقد استخدم بكثرة على واجهات المباني وعلى الخصوص المباني الدينية (غطاء الكعبة، بيت المقدس). ويعرف خط الثلث مباشرة لأن بعض حروفه متوجة بمثلث.
– الرقعة: يسود فهم ضبابي حول سبب التسمية، فهناك من يعزو ذلك إلى الرقعة، أي الورقة الصغيرة، وظني في ذلك يرجع إلى طبيعة الخط، التي تعتمد على الكتابة بشكل مقطع (مرقع)، بمعنى أنه غير مسترسل. ويمتاز هذا بالسهولة، فهو بعيد عن التعقيد وواضح، وله انتشار واسع في الاستعمالات اليومية. ويدخل ضمن مقررات المدارس والمعاهد بالمشرق والخليج.
– الديواني: يمتاز بجماليته وفرادته ضمن الخطوط العربية المعروفة، وتبنى جماليته على حرفي الألف واللام الذي يليه غالبًا في الأسماء.
– الفارسي: ارتبط اسم هذا الخط باسم بلاد فارس لأنه كثير الاستعمال في إيران وباكستان وأفغانستان. يمتاز بالرشاقة والاستدارات الكثيرة والانحراف قليلاً إلى اليمين. وجماله يتوقف على الاشتغال بقلمين. كما أن بعض حروفه لا تكتب إلا بثلث القلم، مثل السين والراء والحاء والهاء في أول الكلام.
مجلة العربي، العدد 569، أبريل 2006م