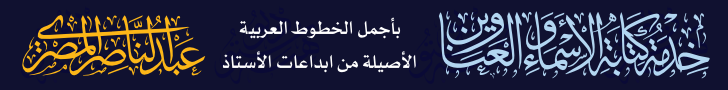تعـددت الآراء والنظريات في أصل الكتابة العربية وكيفية نشوئها، واختلف فيها الباحثون والذين ألفوا في هذا الميدان، فمنهم من قدّر أن أصل الكتابة العربية الدقيق وتاريخها المبكر يكتنفه الغموض، وذهب القسم الأكبر منهم إلى اعتماد الكتابة النبطية المتأخرة مصدراً لنشوء الكتابة العربية اعتماداً على النقوش المحدودة التي كشفت في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن، لذلك كان هذا المقال لوضع النقاط على الحروف في هذا المجال ….
مدخل
وذهبنا إلى أن الكتابة العربية هي من وضع من لهم خبرة في الكتابة الحضرية والتي اخذوا كثيراً من أشكالها بشكل مباشر، واعتمدوا خصائصها في وضع الكتابة العربية الجديدة، وهذا ما أكدته بعض روايات المصادر العربية القديمة التي أشارت إلى اختراعها في “بقة ” إحدى حواضر العرب قبل الإسلام والمجاورة للحضر، كما أن هناك روايات أخرى جاءت بها هذه المصادر أيضا تشير إلى مناشيء أخرى تشكل مصادر لولادة هذه الكتابة، وهي في بنيتها التحليلية ومنظورها المتعمق تعكس الخريطة الكتابية للمنطقة، تذكر السريانية، وتشير إلى الآرامية وتومئ إلى العبرية وتقرر الأبجدية وتصرح بالمسند وتخبر عن الكتابة على الطين وهي الكتابة العراقية القديمة (المسمارية).
إن منظور الدارسين المحدثين لهذه الروايات التي وردت في المصادر العربية القديمة يتأرجح بين الشك أو الرفض، ولربما اعتبرها البعض أقرب إلى الخرافة وقليل منهم من سلك سبيل التحفظ والتريث أو التهرب من تقديم رأي فيها، والأقل من حاول التوفيق بينها وبين المنشأ النبطي في بعض روايتها، وهذا منظور يفتقر إلى النظرة الفاحصة التي تحيط ببواطن الأمور وتمحص ظواهرها، لأن هذه الروايات لم تأت عبثاً ولا هي وليدة خيال جامح، وإنما هي وليدة أصول بعُد أمدها فاهتزت صورها لدى نقلة لم يدركوا كنهها، وفي مقامنا هذا سوف نحاول سبر غور الروايات التي تطرح ” قلم المسند” وهو الكتابة العربية الجنوبية كمصدر لنشوء الكتابة العربية الشمالية والتي رفضت من قبل الدارسين المحدثين إلا ما ندر.
نظرية المسند في أصل الكتابة العربية
أن أقدم من دون نظرية المسند فيما وصلتنا من مصادر ، هو ابن دريد (321 هـ) ولكنه لم يذكر مصدراً لرواة هذه النظرية، وجاء بعده ابن جني (392 هـ) فذكر نفس الرواية ونسبها إلى أبي حاتم (سهل بن محمد السجستاني البصري، ت 255 هـ) وهو أســـبق من ابن دريد، وقد ترددت هذه الرواية عند الجوهـــري (398م أو 400 هـ) والزبيدي (1205 هـ) نقلاً عن أبي حاتم أيضاً
فإذا ما حاولنا لم شتات نظرية المسند من مختلف الروايات التي تعرضت لها، فإننا نجد أنها تقوم على:
1) أن خط الجاهلية هو “الجزم” ذكر ذلك ابن دريد في تقديم نظرية المسند حيث قال: “الجزم خطنا العربي هذا كان يسمى في الجاهلية الجزم”.
2) أن ” الجزم” هو الخط العربي الشمالي والذي كتب له الاستمرار حتى الوقت الحاضر، وهذا واضح في النص المتقدم الذي أورده ابن دريد .
إن ما تقدم عن ” الجزم ” لم يكن قاصراً على نظرية المسند، وأن ما ذكرته الروايات التي تنسب أصل الكتابة العربية إلى منابع أخرى، و بهذا يكون “الجزم” هو العامل المشترك لمحصلة النظريات المختلفة التي طرحت في مختلف المصادر باعتباره الكتابة الجديدة التي نشأت قبل الإسلام – كما سيرد – بغض النظر عن مصادرها أو ما ذكر من روايات مختلفة عن اختراعها أو موطن ولادتها، لكن نظرية المسند تفترق عن هذه الروايات في تفسيرها لمصطلح “الجزم” حينما تبين.
3) أن “الجزم” مجزوم (مقطوع أو مولد) من “المسند”.
4) أن “المسند” هو خط حمير وأهل اليمن الأقدمين.
5) أن “قلم المسند” خط مخالف لخطنا هذا، وهي بذلك تعترف بالخلاف بين شكلي حروف الكتابتين.
6) أن “المسند” قد زال قبل الإسلام، وهذا ثابت ومعروف أكدته التنقيبات الأثرية والأبحاث المستجدة، وأما ما أورده ابن جني والزبيدي من استمرار المسند إلى وقتهم في قولهما المتطابق “والمسند خط حمير في أيام ملكهم، وهو في أيديهم إلى هذا اليوم باليمن” هو قول منقول، حافظ على صيغته المنقولة عندهما مما افقده دقته، وقد كرره ابن منظور (711 هـ) ولكنه وقف عند عبارة “أيام ملكهم” ولم يزد لأنه أدرك أن بقية الجملة مرتبط بوقت رواتها.
7) أن لكندة دورًا في انتقال المسند من أرض اليمن إلى الشمال، حيث ورد أن الذي علم الكتابة لأهل الحيرة طارئ طرأ عليهم من أرض اليمن من كندة، والملاحظ أن هذه الرواية لم يهتم له الباحثون، ولعل مبعث ذلك هو عدم وجود قرينة معاصرة تستدعي الاهتمام بهذه الرواية، ولكن بعد اكتشاف حضارة دولة كندة في التنقيبات الأخيرة في عاصمتها “قرية الغاو”، والتي ساد فيها “قلم المسند” في الكتابة عندها يمكن القول أن ورود كندة في صلب هذه العلمية هو بقايا مؤشر على دورها الحضاري وسيادة كتابتها التي تذكر الرواية:
8) أن الطارئ من قبيلة كندة، أخذ الخط عن الخفلجان بن الوهم، كاتب الوحي للنبي هود عليه السلام الذي عمت كتابته جنوب الجزيرة العربية ومن ثم امتدت إلى شمالها في الكتابة الثمودية واللحيانية والصفوية، والأغرب في نظرية المسند ما ورد من:
9) أن حمير بن سبأ هو أول من كتب الخط العربي، ولا بد أن نشير أننا لسنا بصدد التعرض “لحمير” تحليلاً، وكذلك “الخط العربي” حيث أننا نعتبر ذلك مؤشراً على قلم المسند الذي لم يعرف غيره في اليمن بلد حمير، ولذلك اكتملت النظرية حينما قيل:
10) أن الخط الحميري هو الذي انتقل إلى الحيرة.
11) أو أنه انتقل مباشرة إلى مكة بشخصية حرب بن أمية عن طريق طارئ طرأ عليه من اليمن، تعلمه الطارىء من كاتب الوحي للنبي هود عليه السلام .
12) لا بل إن هناك رواية تفيد أن النبي هود عليه السلام هو أول من كتب بالعربية، وهنا تبلغ النظرية ذروتها.
حينما ندقق في نظرية المسند فإننا نجد أن الأساس فيها هو المخالفة بين قلم المسند وخطنا العربي المبكر معاً يجعلها غير مقبولة لدى الدارسين، وهذا أمر واضح لم يختلف فيه اثنان ممن درسوا الكتابات الجزرية (السامية) وخاصة من الذين تعرضوا لدراسة نظريات نشوء الخط العربي، وعلى ضوء ذلك حاولوا نقد نظرية المسند، فكان رأيهم أنها مسرفة في الخطأ.
أما ما جاء من أن هناك شبهاً في حرف الراء فقط، فهو غير وارد في الكتابة العربية المبكرة، لأن الراء فيها قد أخذ شكله من حرف الراء في الكتابة الحضرية مع إمالة قليلة في وضعها وكانت مرواة وليست على شكل قوس كالذي وصلت إليه فيما بعد. وخاصة في مرحلة الانتقال من الخطوط الموزونة (الكوفي) إلى الكتابة المنسوبة وعلى رأسها خط الثلث. والتي بدأت في كتابات “المسق” على البردي في نهاية القرن الأول الهجري، ومع ذلك لم تأخذ شكل راء المسند.
يتضح مما تقدم أنه لا علاقة للمسند بالخط العربي من حيث شكل الحروف كما توحي به الروايات التي أفادت أن مصدر نشوء الخط العربي هو المسند ، ومع ذلك فإننا نجد أن هناك من يؤيد هذه النظرية.
وممن أيد هذه النظرية من القدامى ابن خلدون (ت 808 هـ)، وقد انطلق في ذلك من نظريته في أن الكتابة مرتبطة بالعمران وتابعة له، حيث قال عن الكتابة أن: “خروجها في الإنسان من القوة إلى الفعل إنما يكون بالتعليم وعلى قدر الاجتماع والعمران والتناغي في الكمالات”، ويلاحظ أنه ربط بين الحاجة إلى الكتابة والمستوى الحضاري، وقد ذكر أن دولة التتابعة وخطهم الحميري هو الوحيد المؤهل لأن يكون مصدر الكتابة التي وصلت “الحيرة” ، لأن أخبار الدويلات العربية التي قامت قبل الإسلام لم تكن تفاصيلها الدقيقة معروفة لدى الأخبار بين القدامى، والتي كشفت عنها التنقيبات والدراسات الحديثة مثل الحضريين والأنباط والتدمريين والرهاويين وكندة وغيرهم.
أما تأييد المحدثين لهذه النظرية فالغالب عليهم التقدير والاستنتاج الذي لم يستند على دراسة منهجية أو فهم دقيق لأوضاع الكتابات في المنطقة قبل الإسلام، ومنها الكتابة العربية في نشوئها وتطورها في صدر الإسلام.
المسند والجزم بعد هذا العرض المركز لنظرية “المسند” في أصل الخط العربي وما ورد من بعض الملاحظات التي اقتضاها السياق، نتساءل : هل أن هذه النظرية لا أساس لها أو أنها نبعت من الفراغ؟ الجواب على ذلك: أن هذا غير ممكن خاصة بعد أن تأكد لنا أن الروايات العربية في أصل الكتابة قائمة على أصول لم يحسن الرواة نقلها، لأن هذا الموضوع بحاجة إلى التخصص والثقافة الكتابية والفنية، ولذلك جاءت رواياتهم بشكل مؤشرات مرموزة لا يمكن حلها بسهولة ومنها هذه النظرية التي يمكن التعرف على مضمونها في كلمة “الجزم” التي وردت كصفة وتسمية للخط العربي قبل الإسلام، إذ أن الجزم لغة “القطع” ، أما اصطلاحاً كتابياً فهو:
1) ضرب من الكتابة شاعت في العصر الجاهلي عند العرب، وحينما جاء الإسلام اعتمدها في تدوين القرآن الكريم ورسمه، فكانت الكتابة الرسمية للعرب والمسلمين حتى الوقت الحاضر بعد أن مرت بعدة أدوار من التطور والتحسين.
2) قلم مستوى السنين لا انحراف في قطته فهو قلم مبسوط وهنا فهو أداة الكتابة سواء كان من القصب أم الجريد أم غيرهما .
3) تسوية الحروف على نسق ووزن ونظام محدد أو مقدر وجد في الخط العربي قبل الإسلام واستمر بعده.
4) توليد كتابة جديدة عن كتابة قديمة، ويمكن أن نلاحظ في هذا المعنى عنصر الابتكار الذي يستفيد من كتابة سابقة.
وحينما نستعرض هذه المعاني الاصطلاحية الأربعة، نجد أن نظرية المسند تتضح في خاصية “تسوية الحروف”، فإذا ألقينا نظرة على الكتابات السائدة في المنطقة نجد أن غالبيتها تفتقر إلى نظام التسوية وتعتمد الخطوط اللينة في رسم مسارات حروفها وضعف الالتزام في مواقعها وتفتقد الدقة في انتظامها ما عدا “المسند” فإن فيه تنظيماً هندسياً فائقاً والتزاماً صارماً في انتظام الحروف ودقة في رسمها، وخاصة في شكله الأحدث (الحميري) الذي اتجه نحو التجويد فظهرت عليه:
1) تغييرات في أشكال بعض الحروف ميزتها عن سابق أشكالها مثل حرف الراء والفاء أو الميم والواو.
2) وزن هذه الحروف على شكل ثابت ووضع معين في المواقع بصورة عامة، وإذا ما كان هناك من خلافات في مستوى الأداء في بعضها فإن ذلك يرجع إلى مقدرة الكاتب أو المنفذ.
3) تحلية الحروف سواء في مسارات أجزائها أو إضافات الترويس ذي الشكل المثلث في نهاياتها، أو حركة في صلب مساراتها من منطلق زخرفي أو جمالي.
4) تشكيل تكوينات فنية من مجموعة حروف لإخفاء مزاياها والتأكيد على أهمية الأسماء التي تكونها وإبرازها بشكل لافت للنظر .
إن هذا التجويد مبعثه الحس الفني الذي تمتع به كاتب المسند باعتباره نتيجة طبيعية لكتابة ترسخت أساليب رسمها على الخطوط اليابسة المنتظمة والتوزيع الموزون القائم على نظام هندسي دقيق في قديمة ليس له مثيل في كتابات المنطقة.
أعقبت هذا التجويد حركة مماثلة في كتابات المنطقة الأخرى في القرون الميلادية الأولى، ولكونها في الأصل كتابات تعتمد المسار اللين في رسومها لذلك لم ترق إلى مستوى المسند ذي الجذر الهندسي المنظم، كما حصل في الكتابات التدمرية ذات الجذر اللين، ثم من بعدها في الكتابة السريانية وخاصة في خطها “السطرنجيلي” التي قرنت بكتابات من خارج المنطقة.
نخلص من كل ذلك إلى أن “المسند” هو الخط الذي تنطبق على رسومه “تسوية الحروف” وهذه الصفة هي إحدى معاني “الجزم” كما مر بنا وهذه الخصوصية تنطبق في التنفيذ على الكتابة العربية قبل الإسلام بشكله المستفاد من أشكال كتابة أخرى، هذه الصفة التي أوضحنا أنها هندسية نتيجة التسوية تتضح بشكل بدائي في نقش زبد 511 م وبشكل أوضح في نقش جبل أسيس 528 م وبشكل تام في نقش حران اللجا 568 م ، وهذا يعني أن هناك نوعاً من الاستفادة المتجزئة مجزومة أو مقطوعة من قلم المسند وهي الصفة الثانية للجزم كما مر بنا والذي يؤكد ذلك ما أورده عبد الله البغدادي (منتصف القرن الثالث الهجري) حينما قال: ” وكان أهل الأنبار يكتبون “المسق” وهو خط فيه خفة، والعرب تقول مشقه بالرمح إذا طعنه طعنًا خفيفًا متتابعًا ، قال ذو الرمة:
فَكَرّ يمشق طعنًا في جواشنها كأنه الأجر في الإقبال يحتسِبُ.
وأهل الحيرة خطوا الجزم وهو خط المصاحف وتعلمه منهم أهل الكوفة، وخط أهل الشام الجليل والسجل”.
إن هذا النص الذي رددته المصادر بعد يوضح أن الكتابة العربية كانت في الأنبار لينة، لأن اختراعها قد تم بتأثير الكتابات الشمالية اللينة وفي أرضها، وحينما انتقلت إلى “الحيرة” دخلت عليها الصفات الهندسية المنظمة المتوفرة في خط المسند فتمت فيها تسوية الحروف، وعندها أطلق عليه في بعض المصادر “الخط الحميري” وبعد أن انتقل إلى الحجاز وعم الجزيرة العربية، ومصرت المدن الإسلامية مثل الكوفة والبصرة لحقت الخط العربي تسميته (الخط الكوفي) عند المتأخرين، لأن الكوفة حلت محل الحيرة التي لا تبعد عنها أكثر من ثلاثة أميال بعد أن هجرها سكانها وتحولت إلى أنقاض. ولم تكن هذه تسميته عند المتقدمين، وإنما أطلق على كتابات القرون الثلاثة الأولى التي تخضع للنظام الهندسي “الخطوط الأصلية الموزونة” أو “الأقلام الموزونة” كما وردت عند أبي العباس ابن ثوبة (ت 277 هـ) فيما نقله عنه ابن النديم أي بمعنى مقدرة بمقدار محدد، قال الله تعالى: ” وأنبتنا فيها من كل شيء موزون” وهو المقابل لمصطلح “تسوية الحروف” أو ” الجزم” كما ورد فيما سبق. وهذا الجزم (الموزون قديماً والكوفي أخيرًا) هو الخط العربي المتطور في العصر الأموي وأوائل العصر العباسي.
لقد تعرضنا فيما تقدم إلى جانب من جوانب “الجزم” أفضى بنا إلى المسند في التنفيذ، بقي أن نذكر أن للجزم جانباً آخر في أصل شكل الحرف العربي أشار إليه السجستاني (ت 317 هـ) حينما قال: ” أن خطنا هذا سمي الجزم، وأول ما كتب ببقة، كتبه قوم من طي يقولون هم من بولان” وقد فصله قبله البلاذري (ت 279 هـ) حينما ذكر أنه: “اجتمع نفر من طيء ببقة وهم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار، ثم تعلمه أهل الجيرة من أهل الأنبار”. إن هذا الخبر يوضح أن الكتابة العربية تولدت أي جزمت أشكالها التي عبر عنها بالهجاء من كتابة سابقة أطلق عليها “السريانية” وقد رجحنا أن الكتابة هي “الكتابة الحضرية” وكلا الكتابتين هما متطورتان عن “الكتابة الآرامية” حيث أخذت الكتابة العربية أكثر أشكال حروفها نقلاً عنها نقلاً أميناً، وما تبقى هي أشكال مطورة من هذه الكتابة في البعض منها أو مبتكرة في بعضها الآخر، والمرجح أن هذه العملية قد تمت بعد سقوط الحضر سنة 241 م ومن ثم انتقلت إلى الأنبار.
إن هذا الجزم هو الأشكال اللينة للحروف العربية التي وردت في الروايات السابقة التي نسبت “المسق” إلى الأنبار، وهذا يشكل الشق الأول لمعنى “الجزم” كتسمية للكتابة العربية قبل الإسلام، وأما الشق الثاني – وهو موضوع بحثنا – فهو الذي تم في الحيرة -كما رأينا سابقاً – إذ أن هذه الحروف اللينة عولجت هندسياً (تمت تسويتها) فاكتسبت الكتابة العربية شكلها النهائي الموزون، أشكال لينة على قياس الحضرية في بقة . والأنبار وتنفيذ هندسي في الحيرة فكان “الجزم” جزماً من الحضرية في الشكل، وجزماً من المسند في التنفيذ، ولما كان هذا الشكل قد ظهر في النقوش التي تعود إلى القرن السادس الميلادي (زيد 511 م وأسيس 528 م وحران 568) ، والتي لم يعثر على غيرها قبل هذه الفترة، فإننا نرجح أن الكتابة العربية اكتسبت هذه الصفة في التنفيذ في بداية القرن السادس الميلادي.
وقد اكتمل هذا التنفيذ في فترة لاحقة بإضافة جديدة هي الأخرى مستفادة من “قلم المسند” ألا وهي الترويس المثلث أو كما أسماها بعض الدارسين “الهامات المثلثة” أو “البرعمي” فقيل “الخط الكوفي ذو الهامات المثلثة” أو “الخط الكوفي البرعمي”.
وقد حاول الباحثون تقديم تعليلات مختلفة لها لكنهم لم يدركوا أن الصورة الانطباعية للترويسات في كتابة المسند وخاصة “الحميرى” منه، وقد وجدت الترويسات هذه بشكل محدود في بعض الحروف على آثار العصر الأموي مثل: الشاهد المؤرخ سنة 71 هـ، وكذلك على أحجار الطريق من عصر الخليفة عبد الملك بن مروان (65-86 هـ / 648-705م) ولعل من أقدم نصوصها المتكاملة في هامات الحروف العليا جميعها الحجر التذكاري لإصلاح الجامع الكبير في مدينة صنعاء المؤرخ سنة 136 هـ/ 753 م من عهد الخليفة العباسي الأول عبد الله السفاح، وقد استمر هذا الترويس فيما بعد ذلك في كافة انواع الخط الكوفي عبر العصور التالية وصارت ميزة اساسية فيه وصفة ثابتة خضعت للتطور في بعض أنواعه المتقدمة، مثل: الخط الكوفي الزخرفي بنوعيه، ذي الفراغ الزخرفي وذي المهاد الزخرفي وكذلك في الكوفي المضفور وكوفي التشكيلات الفنية .
ومما يجب التنويه به أن هناك ترويساً شكله دائري ظهر في العهد الأموي على النقود منذ عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، واستمر في النقود إلى زمن المأمون (198-218هـ/813-833م) في النقود العباسية، يمكن ملاحظته في كتابات الكثير من النقود الذهبية بصورة خاصة، وبصورة أخص في مركز القطع النقدية، ولم يقتصر الترويس الدائري على هامات الحروف وإنما شمل أطرافها، وهو تقليد ورثته تقاليد سك النقود في دور الضرب الموروثة عن البيزنطيين، لأن نفس الظاهرة نجدها في نقودهم، كما وجد هذا النوع من الترويسات في النقود اليونانية والسلوقية والبطلمية، ويظهر أنها ميزة صناعية تتطلبها طريقة إعداد قوالب السك، بدليل شكلها الدائري الذي هو نتيجة حركة المثقب على الأرجح حين البدء في حفر الكتابة، يؤكد ذلك أنها لم تقتصر على الهامات العليا، وإنما شملت أطراف الحروف الأخرى وقد اختفت هذه الظاهرة في النقود في بداية القرن الثالث الهجري. وقد يكون ذلك بسبب تطور أساليب إعداد القوالب وترسخ الخبرة في طريقة إعدادها وحفر الحروف عليها، فكان ظهورها في فترة محددة وعلى النقود فقط، ولم تصبح ظاهرة عامة في الخط الكوفي كما هي الحال في الترويس المثلث المستمد من قلم المسند، وهذا يؤكد أن الظاهرة لا علاقة لها بما حصل في ظاهرة الهامات المثلثلة التي كانت من موضوعات هذا البحث.
الخاتمة
مما تقدم ظهر لدينا أن هناك صفتين في الكتابة المبكرة، والتي أطلق عليها الكتابة الموزونة أو (الخط الكوفي) فيما بعد، تحمل مميزات تقدمت في “قلم المسند” وهي المسارات الهندسية المنظمة التي وصفت في المصادر القديمة على أنها تسوية الحروف، ثم أعقبها الترويس المثلث الذي ميز الخط الكوفي المتطور على مر العصور، وهذا هو مفهوم “الجزم” في الظاهرة التي تمثل الاستفادة من المسند في أسلوب التنفيذ وليس في شكل الحرف الذي هو “جزم” يمثل الاستفادة فيه من كتابة أخرى هي “الكتابة الحضرية ” في الأساس مع تطوير يناسب المرحلة الجديدة التي تمر بها المنطقة والسكان والعرب في حواضرهم في أطراف الجزيرة التي سيطر عليها البيزنطيون والساسانيون والتي بدت فيها بوادر الاستقلال عن هذه الدول في الجوانب السياسية والحضارية المختلفة ، ومنها الكتابة، التي مهدت للنقلة الحضارية الكبرى في تاريخ العرب بظهور الإسلام.
مجلة آفاق عربية 11، 1998/12