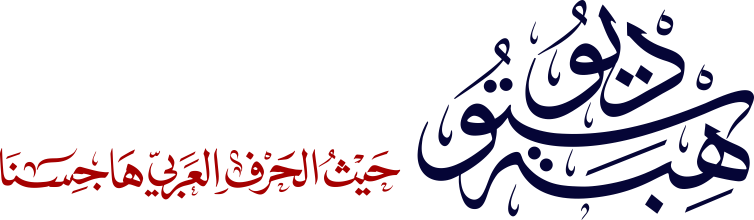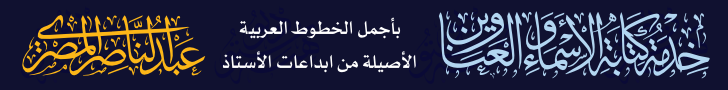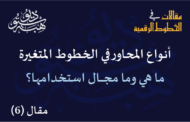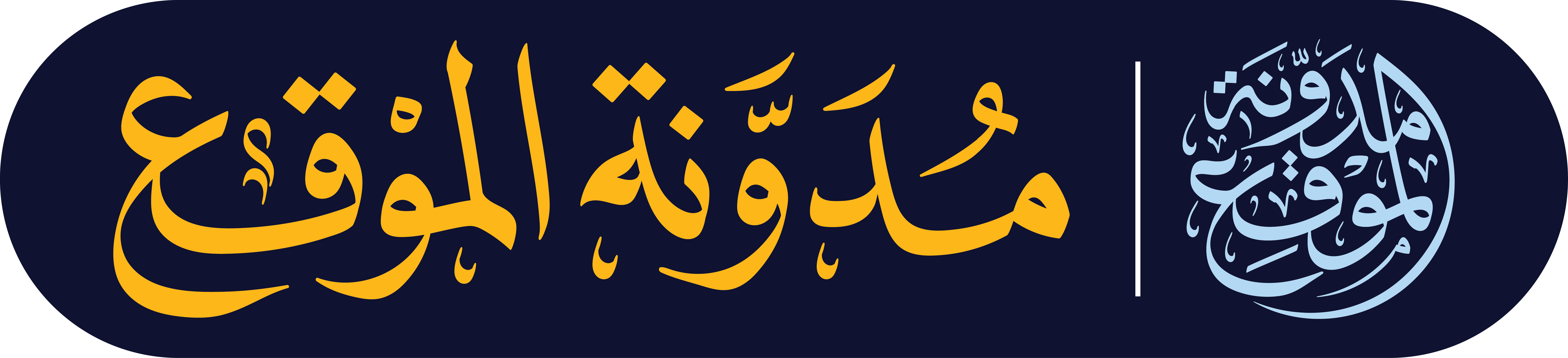نشأة الخط العربي
نشأة الخط العربي
حاول الإنسان منذ قديم الزمان أن يعبّر عن أفكاره وما يدور في خلده، وكان يلجأ في محاولاته هذه إلى أساليب مختلفة بدأها باستخدام الصور والرسوم، ثم تطورت تلك الوسائل بتطور الإنسان وارتقت برقيّه إلى أن توصل في النهاية إلى استخدام اللغة المكتوبة، ثم تعددت اللغات بعد ذلك واختلفت من مكان إلى آخر واستخدمت الأحرف في كتابة اللغة، وتفنّن الناس على اختلاف لغاتهم في كتابة الأحرف ونشأ من ذلك فن الخطاطة والذي عدّه الناس من الفنون الجميلة (1)، فالخط كما هو معلوم فن مبني على أسس زخرفية وقواعد هندسية سواء في الحروف الهجائية أو في الكتابة المختزلة أو في الأرقام العددية (2)، وتشمل الخطاطة أيضاً: الكتابة الصورية والرمزية والمسمارية وغيرها مما استعملته الأمم والأقوام في العهود الغابرة (3)، والخط والكتابة والرقم والسطر والزبر كلها تعني شيئاً واحداً، وقد استخدمها الإنسان منذ زمان طويل، ثم قام بإدخال التعديلات والتحسينات عليها، ويصعب تعيين أي اللغات كانت هي الأقدم في حياة الإنسان، إلا أنه من الممكن الجزم بأن الكتابات الهيروغليفية والآشورية والبابلية والمسمارية والفينيقية كانت من أقدم الكتابات التي ظهرت في الشرق الأدنى والأوسط.
والعرب كغيرهم من الأمم استخدموا الكتابة في التعبير عن آرائهم ومشاعرهم، ولكنهم كانوا يعتمدون أيضاً على الذاكرة اعتماداً كبيراً، فكانوا يحرصون على حفظ جميع ما يسمعونه من الشعر والأدب والأساطير القديمة وعلم الأنساب وغيرها، فقلّ اهتمامهم بالخط والكتابة باستثناء بعض المدن القديمة في الجزيرة العربية والتي راجت فيها الكتابة والقراءة، وهناك روايات تشير إلى أن الخط العربي كان معروفاً قبل الإسلام عند المناذرة واللخميين بالحيرة وعند الغساسنة بتخوم الشام، وكذلك عند القرشيين بمكة (4) والأوس والخزرج واليهود بالمدينة (5) وثقيف بالطائف، وفي بعض مدن شمال الجزيرة العربية كدومة الجندل، والمعلّقات التي نسمع عنها كثيراً مثال جليّ على اهتمام العرب بالكتابة والخط، فقد كان العرب في أيام الجاهلية يعلقون على جدران الكعبة القصائد الشعرية المتميزة بالروعة الأدبية والبلاغية.
واللغة العربية لغة سامية بينها وبين اللغات السامية الأخرى تشابه كبير في الخط والكتابة، وقد أثبت البحث العلمي أن العرب أخذوا طريقتهم في الكتابة من أبناء عمومتهم من الأنباط الذين كانوا في الجاهلية يستوطنون تخوم المدينة في حوران والبتراء ومعان، ويجاورون العرب الحجازيين في تبوك ومدائن صالح في شمال الحجاز، وكانت مملكة الأنباط تمتد من سيناء إلى جنوب سوريا، وقد عثر على بعض النقوش النبطية التي تشبه إلى حد كبير أقدم النقوش العربية المعروفة (6)، والنقوش الكتابية من عهد الأنباط مثل نقش أم الجمال المؤرخ سنة 250م ونقش النمارة المؤرخ سنة 328م ونقش زبد المؤرخ سنة 512م كلها تدل على أن الخط العربي كان قد اقتبس من الخط النبطي، ومن المؤسف أنه ليس لدينا معلومات وافية عن الخطوط المبكّرة للغة العربية، إلا أنه من الأرجح أنها كانت لا تختلف كثيراً عن الخط النبطي، ويحتمل أن خصائصها كانت تختلف من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، وقد تكون الخطوط المعروفة آنذاك تسمى بأسماء المدن والأقاليم التي انتشرت فيها، فالخطوط العربية سمّيت بأسماء المدن والمراكز الإسلامية التي نشأت فيها مثل مكة والمدينة والكوفة والبصرة، والبحث في المراحل التاريخية لتطوّر تلك الحروف ليس أمراً هيّناً وذلك نظراً لندرة النقوش العربية قبل عصر النبوة وعدم احتواء النقش منها على جميع الحروف، ولكنه يمكننا ـ على ضوء دراسة النقوش العربية التي عثر عليها من تلك الفترة ـ أن نرجع الكتابات العربية إلى أصلين اثنين وهما التربيع والتدوير، وهما من أصول الكتابة العربية في جاهليتها وإسلامها، ويرجح أن الخطوط العربية في الحجاز كانت تعتمد على التدوير والليونة منذ بداية نشأتها في مدن تلك المنطقة، ولم تكن الفروق بين هذه الخطوط في الخصائص ولكنها كانت فروق تجويد، ذلك أن العرب عندما عرفوا فن الكتابة كانوا أهل بداوة ولم يكن لديهم من أسباب الاستقرار ما يدعوهم إلى الابتكار في الخط الذي تعرّفوا عليه، ولما ظهر الإسلام في تلك البلاد بلغت الكتابة والخطاطة مبلغ الظاهرة الفنية، حيث صار للعرب دولة تعددت فيها المراكز الثقافية ونافست هذه المراكز بعضها بعضاً على نحو ما حدث في الكوفة والبصرة والشام ومصر ومراكز الثقافة الإسلامية الأخرى في المشرق والمغرب (7)، وبالرغم من وجود الكتابات العربية في الحجاز في العصور الجاهلية إلا أنه لم يصلنا حتى الآن أية نماذج كتابية حجازية ترجع في تاريخها إلى تلك الفترة، كذلك خلت المصادر والمراجع التاريخية من ذكر أية معلومات عن هذه الكتابات.
ومما لا شك فيه أن الإسلام كان له أثر عظيم في انتشار الكتابة العربية وتطورها وازدهارها فقد شجّع على القراءة والكتابة (8)، وكانت الآية الأولى التي نزلت على المسلمين من كتاب ربهم تتضمّن الأمر بالقراءة (اقرأ باسم ربك الذي خلق) وذكر في موضع آخر الأمر بالكتابة حيث أقسم بالقلم وما يسطر به (ن والقلم وما يسطرون)، وغيرها الكثير من الآيات والأحاديث النبوية التي تحض على القراءة والكتابة واستخدام القلم، وكان اعتناق الناس للإسلام باعثاً قوياً لهم على تعلم اللغة العربية لحفظ القرآن وتلاوته تلاوة صحيحة، ومعرفة ما تضمّنه من مبادئ وتعاليم، وكذلك فإن الإسلام قد حرص على نشر العلم في ربوع الدولة الإسلامية، وأصبح تعلم الكتابة أمراً ضرورياً لتدوين القرآن والمعاهدات والصكوك وغيرها من المعاملات التي تحتاج إليها الدولة والمجتمع (9).
وقد وصلت إلينا بعض النماذج للخطوط العربية المبكرة في مطلع فجر الإسلام والتي أمدتنا ببعض المعلومات عن أنواع تلك الخطوط، كما أشارت بعض المصادر التاريخية إلى هذه الخطوط أيضاً، ومن الوثائق التي تنسب إلى تلك الحقبة أربع رسائل يقال أنها رسائل أصلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن المؤسف أن المصادر القديمة لا تزودنا بمعلومات كافية عن خصائص هذه الخطوط المبكرة، فصاحب الفهرست ابن النديم على سبيل المثال لم يذكر عن هذه الخطوط إلا الشيء القليل فيما يتعلق بخصائص الخطين المكي والمدني، كما أنه أشار إليهما باعتبارهما خطاً واحداً إذ يقول:”فأول الخطوط العربية الخط المكي وبعده المدني ثم البصري ثم الكوفي، فأما المكي والمدني ففي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع، وفي شكله انضجاع يسير”، ومن ذلك نفهم أنه لم تكن هناك فروق خصائصية واضحة بين الخط المكي والخط المدني، ويذكر ابن النديم أن من أنواع الخط المدني المدور والمثلث والتئم (10)، وقد تكون صفة كل من المدور والمثلث مفهومة من اسميهما كما قد يكون التئم جمعاً بين النوعين.
ولما انتقل مركز النشاط السياسي والثقافي من الحجاز إلى العراق في أواخر الخلافة الراشدة عرفت جميع الخطوط في تلك المنطقة باسم الخط الحجازي باعتباره مصدر نشأتها، وأغلب الظن أن الخط الحجازي كان يميل إلى الليونة أو شبه الليونة، ولكن مع انتقال مركز النشاط السياسي إلى العراق كان هناك اتجاه إلى استخدام الخط الجامد، حيث ازدهر هذا الخط وبشكل خاص في مدينة الكوفة، فقد عني أهالي الكوفة بهذا الخط عناية خاصة، وأجادوا أصوله وهندسته وأشكاله، ومططت عراقاته واستقامت حتى بدأ هذا الخط يتميز عن الخطوط الحجازية تميزاً واضحاً، واستحق أن ينفرد باسم خاص به وهو الخط الكوفي، ولم يكن هذا الخط في الكوفة فقط بل كان يستخدم في معظم أنحاء العالم الإسلامي، ولكن الاسم الكوفي أصبح اسماً عاماً لهذا الخط اليابس سواء كان في الكوفة أو المدينة المنورة أو في غيرهما، وكانت تكتب به المصاحف واللوحات التذكارية وشواهد القبور، وتُحلى به المباني وتسكّ به النقود، أما الخط الحجازي الليّن فكان غالباً ما يستخدم في المراسلات السريعة والحسابات والأغراض اليومية المختلفة (11)، وقد تزامن ظهور واستخدام الخطين الكوفي والحجازي، وكان لكل منهما خصائص متفردة من البداية، وليس من شك في أنهما يعدان من أقدم الخطوط ظهوراً في الإسلام.
ويعتقد أن الاتجاه نحو ليونة الحروف قد ازداد في عصر الرسالة النبوية نتيجة لازدياد الحاجة إلى الكتابة، وغلب على الخط العربي التقشف والبساطة شأنه في ذلك شأن كل أمور الحياة التي كان يعيشها المسلمون، كما يعتقد أن التطورات الجديدة في استخدام الليونة كانت البادرة الأولى في ظهور خط النسخ (12)، وبهذا نستطيع أن نقول أن نسبة اكتشاف الخط النسخي إلى ابن مقلة لا تصحّ لوجود الخط قبل زمانه، إلا أن ابن مقلة قد أسهم بلا شك إسهاماً كبيراً في وضع القواعد والنسب والجودة لإظهار الخط النسخي كخط متميز عن الخط الكوفي (13)، وقد تنوعت الأقلام في عصر الدولة الأموية وبدأت هندسة الحروف وتجويدها في الفترة الأولى من العصر العباسي بالعراق، ولكن على الرغم من ذلك فإن الخط الكوفي ظل سائداً على الخطوط الأخرى إلى أن استبدل بالخط النسخي في أواخر القرن الخامس الهجري وخاصة في بلاد الشام ومصر، واستمر استخدام الخط الكوفي حتى نهاية العصر الفاطمي، ثم بدأ الأيوبيون في الاعتناء بالخط النسخي حتى شاع في جميع أنحاء العالم الإسلامي وكتبت به الكتب والمطبوعات والمنشورات، ومن الملاحظ أن الخط العربي قد تنوعت أشكاله منذ بداية رحلته، وازدهرت هذه الأشكال في أيام العباسيين فظهر الكثير من الأقلام والخطوط الجديدة مثل الجلي والطومار والبديع المنسوب والإجازة والتوقيع والثلثين، ولكن لم ينتشر استخدام هذه الخطوط بين أفراد الشعب، ومن أشهر هذه الخطوط الخط الثلثي الذي وصل إلى مناطق بعيدة في الأقطار الإسلامية حتى إنه استخدم في بعض النقوش العربية في البنغال.
ولم يتوقف التنوع والتطور في الخطوط العربية في أية فترة من الفترات التاريخية، بل كانت تدخل فيه الابتكارات والإبداعات الجديدة باستمرار إلى أن وصل إلى درجة كبيرة من الجودة والإتقان، ومع أن الخط العربي قد وجد متأخراً بالنسبة لبعض الخطوط الأخرى كالخط السنسكريتي والخط اليوناني إلا أنه انتشر بسرعة فائقة، ولم يكن انتشاره محدوداً في بلاد العرب بل تعدّى ذلك إلى اللغات الأخرى كاللغة الماليزية والأندونيسية والأردية والبنجابية والكشميرية والبلوشية والأفغانية والفارسية والكردية والعثمانية في آسيا، وكذلك اللغة السنغالية والزنجبارية والصومالية والأريتيرية والسواحلية في أفريقيا، واستخدمته بعض شعوب أوروبا لفترة محدودة في بلاد البلقان (14).
واتجه المسلمون في البنغال إلى استخدام الخط العربي بدلاً من الخط البنغالي في اللغة البنغالية، غير أنه مع مرور الزمن وإهمال حكام المسلمين للغة العربية ترك أهل البنغال الخط العربي، وقد حفظ لنا التاريخ بعض دواوين الشعر والمخطوطات البنغالية بالخط العربي والتي كانت قد دوّنت في العصور الوسطى.
الكتابات العربية في شبه القارة الهندية وتطوراتها الفنية
بدأ استخدام اللغة العربية في الهند منذ الأيام الأولى للفتح الإسلامي للسند وذلك في عام 89هـ/708م، وكان أول نقش عثر عليه في الهند هو نقش المسجد الجامع في بنبهور بالسند والمؤرخ سنة 107هـ/727م، وهو أقدم النماذج التي استخدم فيها الخط العربي للكتابة على الأحجار في العصور الإسلامية(15)، وهذا النقش عبارة عن لوحة كتبت بالخط الكوفي وهي تخلو من الشكل والإعجام، ولكنها كتبت بخط جميل واضح روعيت فيه القواعد الفنية مما يدل على تطور الكتابة العربية في تلك المنطقة في ذلك الزمان، وعلى الرغم من أن هذا النقش كان من أقدم نماذج الخط العربي في الهند إلا أنه لم يحظ باهتمام العلماء والباحثين في العالم العربي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخط الكوفي اليابس الجامد لم يستخدمه النقاشون كثيراً في تلك البلاد مع أنه كان من أول الخطوط العربية التي عرفت هناك، ولذلك بدأ يقل استعمال هذا الخط حتى أوشك أن يختفي في بداية القرن السابع الهجري (القرن الثالث عشر الميلادي)، ومن النادر أن نعثر على نماذج من هذا الخط لذلك لم تتوفر لدينا معلومات كافية عن مدى تطور هذا الخط في تلك البلاد خلال هذه الفترة.
ومن النماذج النادرة للخط الكوفي في الهند نقش هوند Hund المؤرخ سنة 482هـ/1090م(16) والذي كتب في عهد الغزنويين، وعثر أيضاً على بعض النقوش المكتوبة بالخط الكوفي في مقاطعة كچها بولاية گجرات، وفي نراول بمقاطعة مهندرغرة وفي سونيپت وجام نگر بمنطقة گجرات وكذلك في مسجد قوة الإسلام بدلهي ومسجد أرهائي دن كاجهونيرا بأجمير وفي ضريح السلطان غوري بمانكهبور بالقرب من دلهي وضريح السلطان إيلتمش بدلهي، وترجع معظم هذه النقوش إلى القرن السابع الهجري الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي أي في أوائل فترة السلاطين المماليك بدلهي، وتحتوي على أنواع مختلفة من الخطوط الكوفية مثل الكوفي البسيط والمورّق والمزهّر، ولا شك أن بعض هذه النقوش التي وجدت في أجمير ودلهي تعتبر من أروع النماذج الكوفية المزخرفة في ذلك العصر (17)، أما المناطق الشرقية للهند كالبنغال مثلاً فلم يعثر فيها إلا على نقش واحد فقط مكتوب بالخط الكوفي، وهذا النقش موجود في مسجد أدينة في مدينة پندوه الأثرية، ويحتوي هذا النقش على سطرين بخط الثلث، بينما نقشت الكتابات الكوفية بحجم صغير على الإطار الأعلى فوق الكتابات المنقوشة بخط الثلث وكأنها استخدمت لغرض الزخرفة فقط.
وعلى الرغم من أن الكتابات الكوفية لم تلعب دوراً رئيساً في هذا النقش إلا أنها تمثل نموذجاً رائعاً للخط الكوفي في تلك المنطقة، وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة استخدام خطين مختلفين كما هو الحال في هذا النقش كانت أمراً شائعاً في بعض البلاد الإسلامية في تلك الآونة، وقد انتشر في تلك الفترة خط النسخ والثلث وقلّ بالمقابل استخدام الخط الكوفي في معظم أنحاء العالم الإسلامي، ولم يستخدم الخط الكوفي بعد ذلك إلا في حالات نادرة مثل كتابة عناوين سور المصاحف والكتابة على النقود.
ومن النماذج النادرة لهذا الخط في نقوش العصور المتأخرة نقش شاه أرجون المؤرخ سنة 938هـ/1532م والذي عثر عليه في سهوان بمنطقة السند وهو الآن محفوظ في المتحف الوطني بكراتشي، وعلى الرغم من أنّ أجزاءه الرئيسة كتبت بخط النستعليق إلا أن هناك عبارة صغيرة نصها: (الله، رسول، علي) مكتوبة بخط كوفي جميل بين شطري بيت من الشعر الفارسي (18).
أما الخط النسخي فقد ساد استخدامه في تلك البلاد -كما أشرنا سابقاً- منذ أن بدأ الحكم الفعلي للمسلمين في الهند وذلك في سنة 591هـ/1194م عندما فتح قطب الدين أيبك وسط الهند وشرقها لأول مرة، وانتشر الخط النسخي قبل ذلك في أفغانستان وخراسان وهي المناطق التي كانت تقدم منها جيوش المسلمين لفتح بلاد الهند، وقد عثر على بعض القطع الحجرية المنقوشة بالخط النسخي في مدينة غزنة عاصمة السلاطين الغزنويين بأفغانستان ذكر فيها اسم السلطان مسعود الثالث، ويمكن أن نخلص من ذلك بأن هذا الخط كان قد انتشر في الهند عن طريق أفغانستان وذلك مع الفتح الإسلامي لدلهي في أيام الغوريين في بداية القرن السابع الهجري، وبدأ الخط النسخي يحتل مكاناً هاماً في جميع الميادين فاستخدم في المعاملات اليومية وفي تدوين أحكام وقوانين الحكومة وفي كتابة المخطوطات والكتب الدراسية والمسكوكات وغيرها، ويعتقد أيضاً أن المناطق الشرقية البعيدة كالبنغال مثلاً كانت قد اتجهت إلى استخدام الخط النسخي في بداية الأمر، فالخط المستخدم في أقدم نقش في البنغال والذي عثر عليه في ضريح سيان في بولپور بمقاطعة بيربهوم والمؤرخ سنة 618هـ/1221م (19) يشبه إلى حد كبير الخط النسخي مع وجود شبه بسيط في بعض حروفه لكلّ من خطي الثلث والرقاع، وليس هذا هو النقش الوحيد الذي كتب بالخط النسخي في بلاد البنغال بل إن هناك عدداً كبيراً من النقوش التي عثر عليها في تلك المنطقة كانت قد كتبت بهذا الخط، كما أن الخط النسخي استخدم أكثر من غيره في كتابة المخطوطات والكتب الدراسية والمعاملات اليومية.
ولا تزال بعض المخطوطات المكتوبة بالخط النسخي والتي دوّنت في عصر السلاطين في البنغال محفوظة في المتاحف المختلفة، ومن هذه المخطوطات مخطوطة حوض الحياة وهي ترجمة لكتاب سنسكريتي بعنوان أمرت كند، ونقله إلى اللغة العربية القاضي ركن الدين السمرقندي في أيام علاء الدين على مردان خلجي بمدينة لكهنوتي، وكذلك يوجد قاموس فارسي باسم فرهنك إبراهيمي والمعروف أيضاً باسم شرفنامة وكاتبه إبراهيم قوان فاروقي، وقد كتبه في أيام ركن الدنيا والدين باربكشاه سلطان البنغال، ويوجد في فهرس المخطوطات العربية والفارسية بمكتبة خدا بخش الشرقية العامة في بانكيپور Khuda Baksh Oriental Library of Bankipur مخطوطة صحيح البخاري في ثلاثة مجلدات، قام بنسخها محمد بن يزدان بخش في قلعة إكدالا في عهد السلطان حسين شاه بالبنغال (20)، وجميع هذه المخطوطات مكتوبة بالخط النسخي، والبنغال معروفة بمخطوطاتها الموضّحة بالرسوم الملونة، ولكن هذه المخطوطات لم يبق منها سوى عدد قليل يعود بتاريخه إلى الفترة السلطانية، ومن أروع الأمثلة على تلك المخطوطات الموضّحة بالألوان مخطوطة اسكندر نامة (21) من أيام السلطان نصرت شاه، وهي محفوظة في المتحف البريطاني بلندن وقد كتبت باللغة الفارسية وتحتوي على قصة خيالية بطلها الاسكندر الأكبر، وتمثل نموذجاً فريداً لاستخدام الخط النسخي في تلك الفترة.
واستمر استخدام الخط النسخي في مجالات عديدة بعد أن استقر الحكم للمغول في بلاد الهند، من ذلك استخدامه في كتابة المصاحف والأحاديث والمخطوطات الدينية والتي كانت تكتب باللغة العربية، وكذلك في النقوش الدينية في المساجد، ثم قلّ بعد ذلك استخدامه ليحلّ محله خط النستعليق، والذي اعتمد في المكاتبات الرسمية وفي كتابة اللغة الفارسية وفي مجالات أخرى مختلفة، ويلاحظ في بعض الكتب الدينية المكتوبة باللغتين العربية والفارسية أن الخطاط يكتب النص العربي منها بالخط النسخي، بينما يكتب الشروح والتعليقات باللغة الفارسية في الحواشي وعلى جانبي الصفحة مستخدماً خط النستعليق، ومن أمثلة ذلك نسخة لمصحف كتبت في العصر المغولي في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، كتبت فيها الآيات القرآنية الكريمة في وسط الصفحة بالخط النسخي، بينما استخدم خط النستعليق في كتابة الحواشي على جانبي الصفحة باللغة الفارسية، ولا تزال هذه الظاهرة متبعة في شبه القارة الهندية حيث تكتب النصوص العربية في الكتب الدينية بالخط النسخي، بينما تكتب الحواشي والشروح باللغة الفارسية أو الأردية أو بإحدى اللغات المحلية، ويستخدم في كتابتها خط النستعليق، فيسهل بذلك على القارئ أن يميّز بين النصوص الأصلية والحواشي، ومن النماذج الرائعة للخط النسخي في فترة الحكم المغولي مصحف محفوظ في المتحف الوطني بمدينة دهاكا في بنغلاديش يعود إلى القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي.
ومن الخطوط العربية الرئيسة التي استخدمت في الهند خط الثلث، ولهذا الخط أيضاً جذور قديمة وعريقة في تلك البلاد، ولا تختلف أصول وقواعد هذا الخط عن الخط النسخي إلا في أمور قليلة، وقد تزامن استخدام هذين الخطين في الهند، ومعظم النقوش في عهد المماليك مكتوبة بخط الثلث، ويمتاز هذا الخط بسماكة حروفه في النقوش المبكرة والتي نجدها في العمائر مثل قطب منار ومسجد قوة الإسلام بدلهي (22) ومسجد أرهائي دن كاجهونپرا في أجمير، ويعدّ بعضها من النماذج الجميلة لكتابة الثلث في أوائل العصر الإسلامي في الهند، وكان خط الثلث أكثر استخداماً بين الفنانين في شرق الهند منذ قدوم المسلمين إلى تلك المناطق، فنقش باري درگاه في بهار المؤرخ سنة 640هـ/1242م والذي يعتبر ثاني أقدم النقوش العربية في شرق الهند كان قد كتب بخط الثلث الجلي على أرضية من الزخارف النباتية، وهناك عدد كبير من النقوش العربية في بلاد البنغال ترجع إلى ما قبل عصر المغول كانت قد كتبت بخط الثلث، ويتميز خط الثلث بالميل في حروفه، إلا أنه قد يصعب التفريق بينه وبين الخط النسخي في كثير من الأحيان، ولذلك اعتبرت معظم الكتابات بخط الثلث من الخط النسخي، وعلى سبيل المثال لم يذكر المؤلف مولوي شمس الدين في كتابه Inscriptions of Bengal نموذجا واحداً بخط الثلث لأنه لم يميّزه عن الخط النسخي، واستمر استخدام خط الثلث في أيام المغول في بلاد البنغال وفي مناطق أخرى في الهند، وكان يستخدم في أغلب الأحيان في كتابة النصوص العربية مثل الخط النسخي، واستخدم أيضاً في الكتابة على اللوحات الحجرية، ومن أروع الأمثلة على النقوش الكتابية التي استخدم فيها خط الثلث نقش براكاترا في مدينة دهاكا بالبنغال والمؤرخ سنة 1055هـ/1645م، وهذا النقش مكتوب بمنتهى الدقة والعناية.

ومن الخطوط الرئيسة أيضاً في الهند خط النستعليق والذي استخدم في وقت متأخر نسبياً، ومع أن هذا الخط شاع استخدامه في الهند بعد قدوم المغول إلا أنه يعتقد بأن فناني الهند كانوا يعرفونه قبل العصر المغولي، وقد تطور هذا الخط وبلغ درجة عالية من الجودة والإتقان عند الفنانين الإيرانيين في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، وكان من أشهر أولئك الخطاطين سلطان علي مشهدي ومحمد علي واللذان عاشا في مدينة هرات، ومن الطريف أن بعض أعمالهم قد وصلت إلى بلاد البنغال، ولا يزال المتحف الوطني ببنغلاديش يحتفظ بنسخة من شرح رباعيات كان سلطان علي مشهدي قد نسخها بخط النستعليق في عام 882هـ/1478م، ويحتفظ هذا المتحف أيضا ببعض أوراق من مخطوطة مخزن الأسرار التي نسخها وزيّنها بالألوان الفنان محمد علي، ومن أقدم الأمثلة على استخدام خط النستعليق في فترة ما قبل العصر المغولي نقش ناگور بمقاطعة راجستهان المؤرخ سنة 888هـ/1483م، وكذلك نقش سوناپت بمقاطعة هريانة المؤرخ سنة 889هـ/1485م، وفي تلك الفترة استخدم خط النستعليق في كتابة المخطوطات، وتحتفظ مكتبة جامعة أدنبرة بمخطوط من الإنجيل مكتوب في الهند باللغة الفارسية بخط النستعليق ومؤرخ سنة 854هـ/1450م، وتحتفظ المكتبة الوطنية Bibliotheque National بمدينة باريس بنسخة مخطوطة من كتاب تاج المعاصر كانت قد نسخت في الهند سنة 870هـ/1465م، وكذلك نسخة لكل من گلستان وبوستان لسعدي الشيرازي والتي نسخت في مدينة سورت بالهند في سنة 854هـ/1450م، ومن أروع النقوش الكتابية المبكرة في منطقة السند والتي استخدم فيها هذا الخط نقش شاه حسن أرجون المؤرخ سنة 938هـ/1531م، وقد عثر عليه في مدينة سهوان في السند، وهو محفوظ الآن في المتحف الوطني بكراتشي، وتوجد في وسط هذا النقش ثلاث كلمات بالخط الكوفي، وقد وصل هذا الخط إلى منتهى الجودة والإتقان في هذه الكتابات، فنسب الحروف متوازنة ودقيقة ليس فيها مدّ أو تقصير أكثر من اللازم، كما تمتاز هذه اللوحة بكثرة الزخارف النباتية التي تملأ إطارها.
وقد كانت أيام حكم المغول فترة ازدهار لهذا الخط إذ اهتم المغول بهذا الخط اهتماماً كبيراً، وبدأ استخدام هذا الخط يسود في جميع الميادين على حساب الخطوط الأخرى، فاستخدم في كتابة الدواوين والمراسلات الرسمية والمخطوطات المتنوعة والنقوش الحجرية وفي سكّ النقود أيضا، والمتاحف في بنغلاديش والهند وباكستان وبعض البلدان الأخرى غنية بالمخطوطات الموضّحة بالصور الملونة والمكتوبة بخط النستعليق من العصر المغولي، ولما كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية في ذلك العصر وكانت تكتب بخط النستعليق شاع استخدام هذا الخط وزاد الاهتمام به، أما اللغة العربية فكانت تكتب بخط النسخ في معظم الأحيان، ومن أمثلة ذلك ما وجد في بعض النقوش العربية المكتوبة بخط النستعليق في مقابر أسرة معصوم خان بمدينة بهكر في السند والتي تعرف أيضاً باسم گورخانة.
وقد بدأ استخدام خط النستعليق في البنغال بعد استقرار حكم المغول وذلك في عهد الإمبراطور أكبر، ويندر أن تجد نموذجاً لهذا الخط في النقوش التي ترجع إلى الفترة السلطانية، ويوجد في مستودع المتحف الوطني في مدينة دهاكا ببنغلاديش ثلاثة نقوش ترجع إلى عهد الإمبراطور أكبر ومؤرخة سنة 1000هـ/1591م، وتدل الكتابة في هذه النقوش على بداية تأثر الكتابات بخط النستعليق في البنغال، وقد كتبت معظم النقوش بعد هذا النقش بخط النستعليق ولكن مع المحافظة على استخدام الخطوط الأخرى في النقوش واللوحات، ومن خصائص حروف النستعليق في هذه الفترة أن الخطاطين كانوا يضعون ثلاث نقاط تحت حرف السين في بعض الأحيان، وكذلك نلاحظ أن حرف گ باللغة الفارسية قد ورد في بعض النقوش على شكل ك.
واستخدمت خطوط أخرى في النقوش الكتابية في فترات مختلفة أثناء الحكم المغولي وقبله، ومن أشهر هذه الخطوط الطغرا، وكانت في بداية الأمر أسلوباً زخرفياً استخدمه الفنانون للزخرفة في الكتابة بخطي الثلث والنسخ، ثم أصبحت خطاً مستقلاً لكثرة استخدامها، وقد بدأت مظاهر هذا الخط تتضح في النقوش التذكارية في منطقة البنغال منذ بداية الحكم الإسلامي فيها وذلك في بداية القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، فالخطوط العمودية للحروف الرأسية كالألفات واللامات تطول إلى أعلى الإطار بشكل منتظم ومتناسق لغرض جمالي، وقد ازدهرت الطغرا في البنغال حتى بلغت درجة عالية في الجودة والإتقان في عصر السلاطين قبل العصر المغولي، كما لقيت إقبالاً شديداً في بعض المناطق الأخرى بالهند مثل گجرات وگولكنده وبيجاپور، وبمرور الزمن تطورت الطغرا وأدخلت فيها التعبيرات التجريدية، وتنوعت أشكالها في أساليب مختلفة، فكان منها ما يشبه القوس والسهام، ومنها ما كان على شكل البجع، وأحيانا تأخذ شكل الزورق والمجداف، وقد كان لقوّة المخيلة عند الفنانين دور كبير في إبداع أنواع مختلفة من أساليب الطغرا ترمز إلى تعبيرات مختلفة، ويلاحظ أن هذه الأساليب الزخرفية كانت من غير قواعد أو أصول ثابتة في نسب الحروف وأشكالها المختلفة، لذلك تمتّع الفنانون بحرية تامة في الإبداع والابتكار.
وعلى الرغم من أن كتابة الطغرا على اللوحات الحجرية كانت قد تطورت كثيراً في القرنين الثامن والتاسع وبداية القرن العاشر الهجري فإنها بدأت تختفي في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري، وذلك عندما انتقل الحكم من الأمراء المستقلين إلى الدولة المغولية، ومن الأمثلة النادرة للطغرا في العصور المتأخرة نقش ضريح ميرزا نظام الدين گولكنده حيث يظهر تأثير الطغرا في ترتيب الألفات واللامات بشكل منتظم، ويلاحظ أيضاً استخدام هذا الأسلوب في نقش مغولي في مسجد بشارع دي سي روي بدهاكا المؤرخ سنة 1052هـ/1642م، فقد حاول فيه الناسخ تمديد الألفات واللامات إلى الأعلى وتنسيقها بأسلوب الطغرا، غير أنه لم يوفّق في إتقان الكتابة على الوجه الذي نراه في كتابة الطغرا في أيام السلاطين.
ومن الخطوط العربية التي تميزت بها شبه القارة الهندية الخط البهاري، وهو من الخطوط التي ندر استخدامها في العالم العربي، وينسب البعض اسمه إلى ولاية بهار في شرق الهند، ولا نستطيع أن نحدد على وجه التحقيق زمن نشأة هذا الخط أو مكان ابتكاره، ومن خصائص هذا الخط أنه كان يكتب بزاوية خاصة من القلم للتحكم في سماكة الحرف في أجزائه المختلفة، فالحرف يبدأ بنقطة رفيعة في أوّله ثم تزداد سماكته تدريجياً إلى أن يصل إلى وسطه، ثم تقلّ السماكة تدريجياً إلى أن ينتهي الخط مرة أخرى على شكل نقطة رفيعة، وتمدّ في هذا الخط بطون الحروف الأفقية مثل حرف السين والياء السيفية أو الراجعة أكثر منها في الخطوط الأخرى، وتمتاز حروف هذا الخط بالميل كما في خط الثلث، أما الحروف الرأسية كالألفات واللامات فتكتب بخط رفيع، ويعدّ هذا الخط جافاً جامداً إذا ما قورن بخط النستعليق أو الخط النسخي، ولذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى اعتباره نوعاً من أنواع الخط الكوفي(23).
ومن أقدم نماذج هذا الخط مصحف محفوظ في مجموعة الأمير صدر الدين آغا خان، وهو منسوخ في قلعة گواليار بالهند ومؤرخ سنة 801 هـ/1398م، وتضم مكتبة تشستر بيتي Chester Beatty في دبلن بإيرلندا وكذلك بعض متاحف باكستان والهند وبنغلاديش عدداً من المصاحف التي كتبت بهذا الخط، حيث أن الخط البهاري كان يستخدم بالدرجة الأولى لكتابة المصاحف، وتمتاز المصاحف المكتوبة بهذا الخط بتعدد ألوان الحبر فيها كالأسود والأحمر والأزرق والذهبي، وندر استخدام هذا الخط في كتابة النقوش، ومن نماذج النقوش العربية المكتوبة بهذا الخط نقش سلطان غنج المؤرخ سنة 835هـ/1432م، ويحتفظ المتحف الهندي بمدينة كلكتا أيضاً بنقش عربي مؤرخ سنة 967هـ/560م يظهر فيه تأثير الخط البهاري، وهناك نقش آخر في متحف أبحاث ورندره براجشاهي يلاحظ من كتابته التأثر بهذا الخط، ولكنه يخلو من تاريخ الإنشاء، ولعله يرجع إلى العصر المغولي حيث ورد فيه ذكر شاه جهان، ونستطيع من معرفة هذه النماذج أن نرجّح أن هذا الخط كان قد نشأ في الهند أو المناطق المجاورة لها كأفغانستان في الفترة ما بين القرنين السابع والثامن الهجريين، واستخدم هذا الخط في كتابة المصاحف في فترة ما قبل العصر المغولي وهو قريب الشبه بالخط الكوفي الشرقي وخاصة النوع الذي كان يستخدم في مدينة هراة بأفغانستان قبيل معرفة الخط البهاري، وهناك قليل من الشبه بين هذا الخط والخط السوداني أحد شطور الخط المغربي الذي كان يستخدم في السودان وتشاد.
ومن الخطوط المستخدمة أيضاً خط الرقاع، وقد وجد في بعض النقوش المبكرة في الهند، ومن أمثلته بعض النقوش التي عثر عليها في مقاطعة كيمبي في ولاية گجرات، ومعظمها ترجع إلى بداية القرن السابع الهجري، وكذلك في منطقة كيرالا في جنوب الهند، ومن أجمل نماذج خط الرقاع في تلك المناطق نقش قصر حاتم خان المؤرخ سنة 707هـ/1307م، وهو موجود حاليا في مدينة بهار شريف بمقاطعة بهار، ومن خصائص هذا النقش أن جميع حروفه متصلة ببعضها في شكل متناسق ومتسلسل، ولذلك كان يطلق على هذا الخط الرقاع المتسلسل، وجدير بالذكر أن هناك نقوشا عديدة في البنغال وبهار كانت قد كتبت بهذا الخط في أوائل الحكم الإسلامي في القرنين السابع والثامن الهجريين، أما بعد قدوم المغول فإن استخدام هذا الخط بدأ يقل في البنغال وفي غيرها من بلاد الهند، وقد عثر على نقش واحد فقط من العصر المغولي كان قد استخدم فيه هذا الخط، وهو النقش المحفوظ في متحف أبحاث ورندره بمدينة راجشاهي.
ومن الخطوط النادرة التي لم تستخدم كثيراً في بلاد الهند خط الإجازة، ومن خصائص هذا الخط أنه كان يجمع بين مميزات خط الثلث والخط النسخي، وقد يكون له هو الآخر أثر فيهما، وخط الإجازة يحتمل التشكيل كخط الثلث، وتبدأ حروفه وتنتهي ببعض الانعطاف، وهو شبيه بالخط الريحاني.
ومن الخطوط النادرة أيضا خط التوقيع، ويحتفظ متحف أبحاث ورندره بمدينة راجشاهي بنموذج رائع له مؤرخ سنة 722هـ/1322م، ويبدو أنه كان من إنتاج أحد الفنانين البارعين، حيث تدل كتابته على نضج الخط وإتقانه، وفي هذا النقش نجد الحروف متصلة ببعضها وتخلو من الشكل والإعجام، ولما كان هناك تسلسل وتشابك في الكتابة سمي الخط في هذا النقش بخط التوقيع المتشابك، ولم يعثر حسب ما توفر لديّ من معلومات على نموذج آخر لهذا الخط.
واستخدم كذلك خط شكسته والخط الديواني في كتابة المخطوطات والمراسلات اليومية وفي الدواوين إبان الفترة المغولية في الهند، لكنهما نادراً ما استخدما في الكتابة على اللوحات الحجرية، ويلاحظ أن خط النستعليق الذي كتب به نقش ضريح شاه مخدوم في عهد شاه جهان والمؤرخ سنة 1045هـ/1634م يشبه إلى حد ما خط شكسته والخط الديواني، حيث أن أذناب بعض الحروف فيه طوّلت إلى الأسفل مع الميل إلى اليسار.
ويمكننا أن نخلص من الحديث عن الكتابة والخطوط العربية في الهند بشكل عام وفي البنغال بشكل خاص إلى أن هذه البلاد كانت قد أسهمت إسهاما كبيرا في استخدام الخط العربي وتطوره، وقد اهتم السلاطين والفنانون بالكتابة وجودتها، وبرز كثير من الخطاطين سواء في فترة حكم المغول أو قبلها، وتنوّعت الخطوط في الفترة التي سبقت حكم المغول، أما في العصر المغولي فقد اشتهر خط النستعليق وامتاز بالجودة الفائقة، ولم يكن استخدام هذا الفن مقتصراً على كتابة النقوش واللوحات الحجرية فحسب بل ساهمت الهند في كتابة المخطوطات وتوضيحها في أصالة تامة عرفت بها على مرّ الأيام، ومع ازدهار جودة الخط على اللوحات الحجرية في البنغال في عصر السلاطين إلا أن كتابة النقوش في الفترات المتأخرة أثناء الحكم المغولي أصبحت أقل جودة إذا ما قورنت بالنقوش العربية في تلك الفترة في دلهي أو أگرا، ولعلّ ذلك يرجع إلى أن البنغال بعد أن أصبحت ولاية من ولايات الهند هجرها كثير من الخطاطين إلى دلهي وأگرا حيث كانت الحكومة المركزية للمغول.
الطغرا البنغالية واستخدامها المتنوع في منطقة البنغال
الطغرا اسم أطلق على أسلوب من أساليب الخطوط العربية التي استخدمت في البنغال في العصر السلطاني، وقد اختلف العلماء والباحثون في تعريف الطغرا، فذهب بعضهم إلى القول بأنها خط مستقل، واعتبرها البعض الآخر أسلوبا زخرفياً بحتاً استخدم في أغلب الأحيان مع الخط النسخي أو خط الثلث، ولما كان هذا الأسلوب قد استخدم في معظم النقوش العربية في البنغال في العصر السلطاني كان لا بدّ أن نتناول هذا الأسلوب بشيء من التفصيل.
من الثابت تاريخياً أن علماء الغرب والمستشرقين كانوا قد تعرفوا على الطغرا عن طريق العثمانيين الذين استخدموها أكثر من أربعة قرون، ولكنها كانت معروفة منذ عهود مبكرة قبل العثمانيين، فقد عرفها السلاجقة العظام وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى (24)، والمسلمون في البنغال والمماليك في مصر، واستخدمها الفنانون المسلمون في النقوش الكتابية في سلطنة غولكندة وحيدرأباد وبيجابور في شبه القارة الهندية في العصور الوسطى.
وأصل كلمة الطغرا مرادف للكلمة الفارسية نشان أو نيشان أو نشانة وتعني علامة وهي مرادفة للكلمة العربية التوقيع، ولقد ذهب ابن خلكان إلى أن هذه الكلمة ليست عربية الأصل حيث يقول في كتابه وفيات الأعيان: “وهي الطرّة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ، ومضمونها نعوت الملك الذي صدر الكتاب عنه، وهي لفظة أعجمية” (25)، ويرى المقريزي أن كلمة الطغرا فارسية الأصل، فيقول في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: “وكان في الدولة السلجوقية يسمى ديوان الإنشاء بديوان الطغرا، وإليه ينسب مؤيد الدين الطغرائي، والطغرا هي طرة المكتوب، فيكتب أعلى البسملة بقلم غليظ ألقاب الملك، وكانت تقوم عندهم مقام خط السلطان بيده على المناشير والكتب، ويستغنى بها عن علامة السلطان، وهي لفظة فارسية”، واستخدمت الطغرا في صورة الفعل بمعنى ختم بالطغرا في موضع آخر في الكتاب نفسه، حيث يقول: “تمتاز المناشير المفتتح فيها بالحمد لله أول الخطبة أن تطغر بالسواد، وتتضمن اسم السلطان وألقابه، وقد بطلت الطغرا في وقتنا الحاضر” (26).
ومع أن أكثر الباحثين يرون أن كلمة الطغرا من أصل فارسي أو من لغة أخرى خلاف التركية، إلا أن الأرجح أن يكون أصلها من اللغة التركية القديمة كما ذكر في دائرة المعارف الإسلامية وصرح به بعض أهل العلم، فيرى كاشغري أن كلمة طغرا مشتقة من كلمة طغراغ وهي كلمة من لهجة الأوغوزي، ولعل حذف الحرف الأخير من الكلمة وهو الغين يرجع إلى ما درج عليه الاستعمال في اللغة التركية العثمانية من إسقاط الحرف الحلقي الأخير في لغة الأغوز (27)، وذكر القلقشندي في مواضع عديدة أن القانات وهم أمراء الأتراك في وسط آسيا كانوا يستخدمون الطغرا في كتبهم للافتتاحيات، ولكن تجدر الإشارة إلى أن صورة الطغرا عند الدول التي سبقت الدولة العثمانية كانت تختلف عن الصورة التي عرفها العثمانيون، كما أن معنى الكلمة واستخدامها قد اختلف من مكان إلى آخر، فالعثمانيون والمماليك استخدموها للتوقيع وشعارات الحكومة، بينما استخدمها الفنانون المسلمون في البنغال وبعض الولايات في الهند للنقش على اللوحات الحجرية، واستخدمها فيروز شاه سلطان دلهي كشعار لحكومته على المسكوكات.
ولم يتوفر لدينا أي نموذج للطغرا التي استخدمها الأغوز، كما أنه من العسير أن نتعرف على خصائص الطغرا التي استخدمها السلاجقة العظام أو سلاجقة الروم، إلا أن الأرجح أنها كانت على هيئة القوس وكان اسم السلطان يكتب تحت القوس، ويعتقد أن السلاطين المماليك في مصر عرفوا الطغرا من السلاجقة عن طريق الأيوبيين، وكانت الطغرا عند المماليك على هيئة مستطيلة مملوءة بخطوط رأسية متوازية ومتناسقة، مكتوية على منتصبات الألف واللام والطاء والظاء، قريبة بعضها من بعض، وفي قاعدة المستطيل يكتب اسم السلطان وألقابه.
وقد فصّل القلقشندي في ذكر خصائص الطغرا التي كان سلاطين مصر يضعونها على مراسيمهم والأوامر العالية التي يوجّهونها إلى مقدمي الألف أو أمير الطبلخانة، وكان يوكل إلى عامل خاص إعداد هذه الطغراوات على قطع مستطيلة من الورق، وكان على الكاتب أن يضع تلك المستطيلات بعد ذلك في المسافات المخصصة لها على بياض في الطرة أو الجزء الأعلى من الوثيقة، وفي وصف كتابة الطغرا وهندستها وتركيب أجزائها وطولها وعرضها يقول القلقشندي: “واعلم أن الطغراوات تختلف في تركيباتها باعتبار كثرة منتصباتها من الحروف أو قلّتها، وباعتبار كثرة آباء ذلك السلطان أو قلّتهم، ويحتاج واضعها إلى مراعاة قلة منتصبات الكلام أو كثرتها، فإن كانت قليلة أتي بالمنتصبات بقلم جليل مبسوط كمختصر الطومار ونحوه لتملأ على قلتها فضاء الورق من قطع الثلثين أو النصف، وإن كانت كثيرة أتي بالمنتصبات بقلم أدق من ذلك كجليل الثلث ونحوه اكتفاء بكثرة المنتصبات عن بسطها، ويختلف الحال في طول المنتصبات وقصرها باعتبار قطع الورق، فتكون منتصباتها في قطع الورق دون منتصباتها في قطع الثلثين”، ونخلص من ذلك أن الطغرا لم تكن كتابتها محدودة في خط واحد، بل كانت تكتب بخطوط مختلفة كخط الثلث والطومار والثلثين والنسخي والمحقق وغيرها، وهذا ما أكّده القلقشندي في كتابه صبح الأعشى في صناعة الإنشا حيث يقول: “وقد كتب في الدولة الناصرية فرج بن الظاهر برقوق للقان القائم بها في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة في قطع البغدادي الكامل من الورق المصري المعمول على هيئة البغدادي، ابتدأ فيه بعد خمسة أوصال بياض بالبسملة في أعلى الوصل السادس وببياض من جانبها عرض أصبعين من كل جهة، والسطر الثاني على سمته في آخر الوصل بخلو بياض من الجانبين بقدر السطر الأول، والطغرا بينهما بألقاب سلطاننا على العادة، مكتوبة بالذهب بالقلم المحقق المزمك بالسواد بأعلى الطغرا قدر عرض ثلاثة أصابع بياضاً ومثل ذلك من أسفلها، وباقي السطور بهامش من الجانب الأيمن على العادة، وبين كل سطرين قدر نصف ذراع القماش القاهري، والأسماء المعظمة من اسم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واسم سلطاننا والسلطان المكتوب إليه والضمير العائد على واحد منهما بالذهب المزمك”.
ويعرض القلقشندي بشيء من التفصيل لصورتين من طغراوات سلاطين مصر، وأولى هاتين الصورتين تمثل طغرا السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وهو من أشهر سلاطين المماليك، ونجد فيها أن منتصبات الحروف الرأسية كالألف واللام والطاء قائمة برأسها، كثيرة الطول، تتناوب مع مجموعات من المنتصبات المزدوجة، وتحقيقا لهذا الترتيب المنتظم فقد وضعت بعض الحروف في غير مواضعها، ومن أمثلة ذلك حرف الألف في لفظ الملك وهي الكلمة الثانية من البداية كانت قد وضعت بين لامي السلطان في أول السطر، ومكتوب تحت سطر الألقاب: خلّد الله سلطانه، وغالبا لا يكتبها العامل الموكل بالطغرا، بل الكاتب الذي كتب المنشور نفسه.
أما الصورة الثانية فيقول فيها القلقشندي:”وهذه نسخة طغرا منشور أيضاً بألقاب السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون مضمونها – السلطان الملك الأشرف ناصر الدنيا والدين ابن الملك الأمجد ابن السلطان الملك الناصر ابن الملك المنصور قلاوون – عدد منتصباتها من الألفات وما في معناها خمسة وأربعون منتصباً، بقلم جليل الثلث، بين كل منتصبين قدر منتصب مرتين بياضاً، طولها ثلث ذراع وربع ذراع بالذراع المقدم ذكره وعرضها كذلك، واسم السلطان بأعاليها بقلم الطومار بالحبر قاطع ومقطوع كما أشار إليه في التعريف، مثاله: شعبان بن حسين، الشين والعين والباء والألف سطر والنون من شعبان وابن سطر مركب فوق الشين والعين وحسين سطر مركب فوق ذلك، وطول ألف شعبان تقدير سدس ذراع، وقد قطعت النون الألف وخرجت عنها بقدر يسير، وأول الاسم بعد المنتصب السادس عشر من المنتصبات، وآخر النون من حسين البارزة عن ألف شعبان إلى جهة اليسار بعدها منتصباً من جهة اليسار”، ويذكر القلقشندي أيضاً أن طغرا المماليك في مصر بدأ استعمالها يختفي مع بداية عهد شعبان بن حسين.
ومن الملاحظ أن استخدام الطغرا في عهد المماليك في مصر قد تزامن مع استخدامها في عهد السلاطين في البنغال، فلا غرابة أن يكون هناك تشابه كبير بين الطغراوات في كلا البلدين، وجدير بالذكر أنه كانت هناك روابط قوية بين مصر والبنغال في تلك الفترة، وخاصة في عهد جلال الدنيا والدين محمد شاه الذي أرسل وفده إلى السلطان الملك الأشرف برسباي مع بعض الهدايا، وقد ردّ السلطان برسباي على ذلك فقام أيضاً بإرسال الهدايا إلى سلطان البنغال، ولعل طغرا البنغال كانت قد تأثرت بطغرا المماليك التي بدأ استخدامها في مصر قبل استخدامها في البنغال بزمن قليل، غير أن طغرا البنغال كان لها مجال أوسع في الاستخدام، فقد كانت أسلوباً رئيساً في الكتابات الحجرية، واستخدمها علماء فن المسكوكات كعنصر من عناصر الزخرفة الكتابية على المسكوكات، ولذلك اختلفت الطغرا في مدلولها وطريقة استخدامها هناك عنها في الأقطار الإسلامية الأخرى خارج شبه القارة الهندية، ومن الملاحظ أن عناصر معظم كتابات الطغرا في البنغال تشابه عناصر طغرا المماليك أكثر من شبهها لعناصر طغرا العثمانيين، وخاصة في طول منتصبات جميع الحروف الرأسية، وتماثل بعضها مع بعض، إلافي نموذج واحد للطغرا وجد على نقش تذكاري في عهد باربكشاه وهو يشبه الطغرا العثمانية إلى حدّ كبير.
وليس من الهين أن نتعرف على الطريقة التي وصلت بها الطغرا إلى البنغال، إلا أنه لا يخفى أن هجمات المغول على المراكز الحضارية الإسلامية في وسط آسيا والشرق الأدنى والاضطرابات السياسية في تلك البلدان قد أدت إلى هرب كثير من الفنانين والخطاطين المسلمين إلى البلدان الإسلامية البعيدة المأمونة والتي لم تتأثر من هذه الهجمات مثل مصر والبنغال، وكان بعد البنغال عن ساحة الحرب المغولية سبباً في اختيار كثير من الفنانين لها كملجأ آمن، وكذلك فإن حكام البنغال كانوا يرحّبون بالفنانين ويستقبلونهم خير استقبال، ويقومون بالإضافة إلى ذلك بتشجيع الفنانين في الاستمرار في أعمالهم الفنية، ونتيجة لذلك أنتجت البنغال أرقى وأنفس التحف الفنية، وأغلب الظن أن الطغرا وصلت البنغال عن طريق هؤلاء الفنانين الذين تعرفوا عليها من السلاجقة، ثم استخدموها في البنغال إلى أن أصبحت أكبر مظهر للزخرفة الكتابية في البنغال في ذلك الوقت.
وقد تردّد بعض أهل العلم في اعتبار الطغرا خطاً مستقلاً، حيث كانوا يرونها أسلوباً زخرفياً بحتاً يستخدم لزخرفة كتابة النسخ والثلث، وللعلماء آراء مختلفة في الرموز التي ترمي إليها خطوط الطغرا وأشكالها، فبعضهم يرى أن تنظيم الخطوط المتوازية في أسلوب الطغرا يرمز إلى استعراض الصفوف العسكرية المنتظمة في مواكب الاحتفالات، ويرى البعض أن هذا التنظيم يرمز إلى المركب والمجداف، ويرى آخرون أنه يرمز إلى صفوف المصلين في الجماعة، وقد أطلق على الطرز المختلفة لطغرا البنغال أسماء لها علاقة بشكل الأسلوب المستخدم، فالأسلوب الذي يشبه في شكله البجع يسمى طغرا من نوع البجع، وهناك نوع آخر باسم الأرجون والمزمار، وهناك نوع ثالث سماه الدكتور يزداني أسلوب القوس والسهام حيث منتصبات الحروف الرأسية تمثل السهام، في حين يمثل حرف النون في أشكاله المفردة القوس التي تزين السهام في أعلاها، ويلاحظ أن جميع حروف النون المفردة غير المتصلة على أشكالها القوسية قد توضع على رؤوس المنتصبات الطويلة والمتوازية بعيدة عن مستوى السطح وهو خط استواء الكتابة.
ومما لا شك فيه أن الطغرا قد أعطت الفنانين فرصاً للإبداع الفني لم تتوفر في الكتابات الأخرى، وساعدت بذلك هؤلاء الفنانين على تحقيق أهدافهم الفنية، فهي ابتداءً تمنح الفنانين استقلالاً كاملاً عن قيود الترتيب المتعاقب في تنظيم الحروف خلال كتابتهم، حيث تعطي الكاتب الحرية في كتابة كلمات كثيرة ونصوص طويلة في مكان ضيق ومحدود، في الوقت الذي يتعذر فعل ذلك في حالة استخدام الكتابات الأخرى، لذلك نجد أن ترتيب النصوص الطويلة في مكان محدود على اللوحات الحجرية أجبر الفنانين على كتابة الحروف والكلمات فوق بعضها البعض، وأحياناً في غير موضعها الأصلي، لدرجة أنه يصعب في كثير من الأحيان الاهتداء إلى الترتيب الصحيح للحروف والكلمات في السطر الواحد، وبالإضافة إلى ذلك فإنها أعطت الفنانين فرصة لإشباع رغبتهم الفنية في الرسم والتصوير بوساطة الكتابة من غير الوقوع في محظور شرعي، فملأت بذلك الفراغ الذي نشأ بسبب تحريم الإسلام لرسم الكائنات الحية، حيث اشتملت على عناصر جمالية ترمز إلى بعض الأشكال الموجودة في الكائنات الحية.
وقد أبدع الفنانون في البنغال إبداعاً كبيراً في استخدام الطغرا، إلا أنه مع نهاية القرن التاسع الهجري بدأ أسلوب الطغرا يختفي شيئاً فشيئاً إلى أن دخل المغول البنغال وتوقف استخدامها بالكلية، ولم يعثر على أي نموذج لهذا الخط منذ بداية العصر المغولي، غير أن الطغرا في الدولة العثمانية ظلت تحتفظ بمكانة خاصة لمدة طويلة، ومعلوم أن الطغرا العثمانية لم تكن إلا صورة من تلك الصور الزخرفية التي أبدعها الخطاطون العثمانيون من جملة ما أبدعوه من صور جميلة للخط العربي، ولم يقتصر استعمالهم لها على التوقيع على الفرمانات، بل اتخذوها أيضا أساساً لكتابة بعض العبارات الدينية كالبسملة والشهادتين وغيرهما (28)، ولكن قلّ أن يستخدموها للنقش على اللوحات.
وتختلف الطغرا العثمانية في مظهرها وأشكالها عن طغرا المماليك في مصر، فالطغرا العثمانية تقتصر على اسم السلطان وألقابه، وتخلو في بعض الأحيان من الزخارف، وأحياناً تكون مزخرفة بأزهار القرنفل واللوتس، ومن أجمل أمثلة هذا النوع مسكوكة تحمل اسم السلطان سليمان القانوني، وأقدم الطغراوات العثمانية المعروفة هي الطغرا التي نقشت على سكة الأمير سليمان بتاريخ 802هـ-81هــ، وفي هذه الطغرا تجد أن الحروف الرأسية الثلاثة قد أخذت من الألفات في اسم الأمير وأبيه، وأن الأقواس البيضاوية والأشكال الهلالية غير مغلقة وتلتقي في الجزء الأسفل من اسم الأمير، ويبدو أن هذه الأقواس كانت أصلاً امتدادات لحروف النون التي ترد في كلمة بن أو ابن، وهناك بعض النماذج للطغرا العثمانية على شكل طائر، وبعضها يأخذ شكل فارس ينهب الأرض نهباً، ويستدل بعض العلماء على ذلك من كلمة طوغ التي كان الأتراك يطلقونها على الحصان، ثم جرت على ألسنة العامة فأطلقوا عليها اسم طوغرا، ومع مرور الزمن أصبحت تسمى طغرا.
ويرى فون هامر أن الطغراوات قد ظهرت في عهد مراد الأول أو أبيه أورخان، غير أنه لم يأت بدليل قاطع على دعواه، كما يرى أن الطغرا كانت تقليدا للعلامة المختلفة من أصابع يد السلطان مراد الأول، وذلك لأن هذا السلطان لم يكن يعرف الكتابة، وهذا الرأي يفتقر أيضا للدليل العلمي.
وقد خصص الأتراك للعاملين بالطغرا رتباً مختلفة، ومن هذه الرتب رتبة النشانجي، وهو الذي كان يعدّ القوانين ثم يضع الطغرا عليها، وكان منصبه أشبه ما يكون بمنصب المفتي القانوني، ولما اتسعت رقعة البلاد اضطر النشانجية إلى الاستعانة بموظفين آخرين أطلق عليهم لقب الطغراكش نسبة إلى الطغرا، ومع العناية الخاصة التي أولاها العثمانيون للطغرا إلا أن استعمالها الرسمي في تركيا قد توقف بمرسوم قانون أنقرة الصادر في نوفمبر 1922م وذلك بعد خلع السلطان عبد الحميد آخر سلاطين الأتراك من الحكم.
وبمقارنة الطغراوات الثلاث نجد أن العنصر المشترك بينها هو منتصبات الحروف الرأسية التي نجدها في أسلوب الطغرا في البنغال وفي بعض المناطق الأخرى في شبه القارة الهندية مثل دولة غولگنده وبيجابور وحيدرأباد، وهذه المنتصبات هي السمة الأساسية لأسلوب الطغرا، أما أشكال الأقواس فكانت من خصائصها أيضاً إلا أنها لم تكن شرطاً أساسياً لها، فمعظم الطغراوات كانت خالية من الأقواس وخاصة في مصر أثناء عهد المماليك، وكذلك تميّز التصميم الزخرفي الذي وجد فيها من بداية ظهور الطغرا بالحروف الرأسية والتي تعتبر من أقدم عناصر الطغرا.
ومن الملاحظ أن الطغرا أصبحت بمرور الزمن شعاراً للدولة، فلم يكن الحاكم يستخدمها للتوقيع على الأوامر العالية والفرمانات فحسب، بل كان يوقّع بها أيضاً على حجج الأملاك والسكة والنصب التذكارية الرسمية والسفن الحربية، واستمر التوقيع بها على الوثائق وجوازات السفر وطوابع البريد وأوراق الدفعة ودمغات الصيّاغ وغيرها في البلدان الإسلامية المختلفة إلى وقت قريب، وأحدث الأمثلة على استخدامها هو ما نجده في بعض المسكوكات الباكستانية حيث نقش عليها شعار الحكومة على طراز الطغرا.
وانتشرت الطغرا بين عامة الناس أيضاً، وقد لجأ البعض إلى تقليد أشكالها واستخدامها في كتابة العبارات التي كانوا يضعونها في المساجد أو المقاهي أو في منازلهم الخاصة، وتوجد في مصر اليوم علامات تجارية مستوحاة من الطغرا (29)، كما يمكنك أن ترى الطغرا في أجمل أشكالها في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث استخدمت لتزيين عمود من الأعمدة في قاعة الوصول للصالة الدولية التابعة للخطوط السعودية، فكتبت البسملة في مجسم معدني في شكل حديث مستوحى من الطغرا العثمانية، وهذه الأمثلة تدل على استمرار استخدام الطغرا في الزخرفة في مختلف المجالات والأغراض، ولعل تطور فن الچرافيك بصورة عامة واستخدام الإمكانات الحديثة في تنفيذها قد ساعد على ذلك.
الهوامش
1) عبد العزيز الدالي. الخطاطة الكتابية العربية، مكتبة الخانجي، مصر، 1400هـ، ص 3.
2) Abdul Kabir Khutaibi and Mohammad Sezelmasi, The Splendour of Islamic Calligraphy (Thomas and Hudson: London, 1976), 20.
3) سهيلة ياسين الجبوري. الخط العربي وتطوره في العصور العباسية، مكتبة الظهراء، بغداد، 1381هـ، ص 1-2
4) الدكتور صلاح الدين المنجد. دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي، دار الكتاب الجديد، 1972م، ص 23.
5) الخطاطة الكتابية العربية. سبق الإشارة إليه، ص 42.
6) الدكتور إبراهيم جمعة. دراسة في تطور الكتابات الكوفية، دار الفكر العربي، ص 17.
7) الخطاطة الكتابية العربية. سبق الإشارة إليه، ص 37.
8) سهيلة ياسين الجبوري. أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي، جامعة بغداد، 1977م، ص 77-85.
9) أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي. سبق الإشارة إليه، ص 78.
10) ابن النديم. الفهرست، المطبعة الرحمانية، مصر، 1348هـ، ص 8 وما بعدها.
11) دراسة في تطور الكتابات الكوفية. سبق الإشارة إليه، ص 17.
12) أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي. سبق الإشارة إليه، ص 142.
13) عبد الكريم الخطيبي والدكتور محمد السجلماسي. ديوان الخط العربي، ترجمة محمد برادة، دار العودة، بيروت، ص 119-121.
14) عبد الفتاح عبادة. انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والغربي، مطبعة هندية بالموسكي بمصر، 1915م، ص 102-111.
15) Mustafizur Rahman, Islamic Calligraghy, Plate 1.
16) Ibid, pp. 23-24.
17) Annemari Schimmel, Islamic Calligraphy (Leiden: E.J. Brill, 1970), Plate X (a,b,c).
18) Dr. Muhammad Abdul Ghafur, “A Persian Inscription of Shah Arghun,” J.A.S.P., Vol. VII. (December 1962): 277-288.
19) Z.A. Desai, “An Early Thirteenth Century Inscription from West Bengal,” E.I.A.P.S. (1975): 6-12.
20) Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library of Bankipur Vol V., Part 1., No. 130-132.
21) Robert Skelton and Mark Francis ed., Arts of Bengal, The Heritage of Banngladesh and Eastern India (London: Whitechapel Art Gallery, 1979), 34.
22) N. M. Ganam, Development of Muslim Calligraphy in India, Paper presented in South Asian Workshop on Epigraphy, Department of Epigraphy, Mysore, 25-31 March, 1985, pp. 2-7.
23) Mustafizur Rahman, Islamic Calligraghy, p. 47.
24) عبد العزيز مرزوق. الفنون الزخرفية الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1938م، ص 180-181.
25) وفيات الأعيان. تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1969م، جزء 2، ص 190.
26) تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي. الخطط، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرة، 1370هـ، جزء 2، ص 226.
27) دائرة المعارف الإسلامية. انتشارات جهان، تهران، 1352هـ-1933م، الطبعة الأولى، جزء 15، ص 203 وما بعدها.
28) الفنون الزخرفية الإسلامية. سبق الإشارة إليه، ص 182.
29) دائرة المعارف الإسلامية. سبق الإشارة إليه، ص 210.