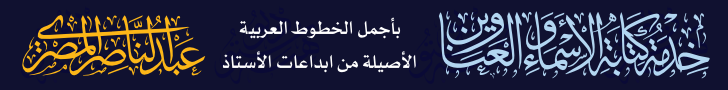(الإمتاع والمؤانسة) هما الهدف المشترك بين الفنون والآداب جميعها، وكأنّ هذه الفنون – على اختلافها ظاهراً وتوحدها باطناً – تتنافس فيما بينها لإحراز أكبر قدر من الجمال المطلق … ولن تصل إليه بطبيعة الحال … لأن كل ما هو مطلق هو من صفات الله جل وعلا (رفعت الأقلام وجُفّت الصحف).
ولكنها تصل على الجمال النسبي (الاصطلاحي) المشوب بالنقص والكدر، ولا يتفاوت المبدعون فيما بينهم إلاّ بمقدار وجود نسبة هذا النقص في أعمالهم – انخفاضاً أو ارتفاعاً – أو يتفاوتون بالقدرة على تجميل النقائص والعيوب وممارسة ما يُسمى (خداع النظر والسمع) في محاولة صرف الانتباه عنها … وهذا يُفسّر قول الأدباء المرموقين – وهم يصفون ا عمالهم – : “أرجو ممن نظر إلى عملي أن يسيل ذيل الستر عليه، وأن يغض الطرف عن عيوبه، فإن الكريم يصفح .. واللئيم يفضح”.
وإذا كان هذا القول وما يُشبهه يدخل في باب التواضع المحمود الذي عرف به العلماء الكبار … فإنه – في الوقت نفسه – وصف دقيق لحقيقة الحال … ذلك أن العالم المبدع – أديباً كان أو موسيقياً أو خطاطاً – يدفعه طموحه المتقد ونفسه الوثّابة وهمته العالية إلى تركيز همه واهتمامه على المنطقة العلمية الفنية التي لم يحرزها ولم يسبر أغوارها بعد، فيرى نفسه مقصراً أيّما ت قصير … بينما يراه الناس محلقاً أيّما تحليق … ولا يلتفت أبداً إلى الوراء، لأن الالتفات من شأنه أن يذكره بإنجازاته، فيُضيّع الوقت الثمين – وهو يستعرضها متلذذاً – وقد يقع في مطبّ العجب والغرور … ومن هنا قال المتصوفة: (ملتفت لا يصل).
وقد جاء في الأثر: “اللهم اجعلني في عين نفسي صغيراً … وفي أعين الناس كبيراً”.
مستقر الفنون والآداب ومستودعها واحد .. ألا وهو (القلب العاقل)، ولكن دهاليز الوصول إليه تختلف بين فن وآخر … فالموسيقى والأدب يلجان القلب العاقل عن طريق إطراب الأذن وإثارة منطقة الخيال والتصورات … أمّا فن الخط فطريقة إدهاش (العين)، وإمتاع منطقة الذوق السليم، والارتقاء بها إلى سموات اللطف الروحي من خلال قوة النص (الأدبية) وروعة هندسته (الفنية) … الشاعر يتلمس مواطن الجمال حوله، فيُجنّد موهبته في تصويرها أجمل تصوير ممكن، ويضفي عليها من خياله المجنح لمسات الإمتاع والسحر … ولابد له من الالتزام بضوابط اللغة والقافية والوزن الشعري … ولكنه – في الحقيقة – يلتزم بها ظاهراً، ويخترقها باطناً من خلال روح التجديد والابتكار التي يتمتع بها، لعله ينشيء (وحدة حال) مع المتلقي من خلال إمتاع قلبه وصولاً إلى إقناع عقله.
فإذا كان الموضوع الشعري من الأهمية بمكان بحيث يتعلق الأمل بالأمة كلها .. سار إليه – على الأغلب – على أشرعة (البحر البسيط) أو الكامل … أو الطويل … المعروفة بأوزانها القوية المؤثرة، وانتقى له قافية مجلجلة ومفردات جزلة متينة …
أمّا إذا كان الموضوع داخلاً في باب (الإخوانيات) أو باب (النجوى) الشخصية، فتراه يمتطى بحراً ناعم الإيقاع (كالرجز أو الرمل أو الهزج)، وينتقي قافية (حالمة) ومفردات سلسة، وربما لجأ إلى الشعر (التفعيلة) العذب الانسياب … الخ.
وكذلك الموسيقى … يمتطي مقام (الرصد) القوي للأعمال الكبرى … أو (البيات) … وينتقي للمقاطع الحزينة مقام (الصبا) أو (الحجاز)، ولأغاني الأطفال مقام (العجم) المفرح، ولنجوى الحب يسعفه مقام (النهاوند) الناعم للتعبير عمّا يجيش في صدره من عواطف دافئة.
والخطاط المبدع الذي يقضي عمره بين (بكاء قلمه وضحكة قرطاسه) لديه أيضاً خيارات مشابهة: فخط الثلث الجلي – بقوته وشموخه – يناسب النص القوي الشامخ، لذلك نجد أن معظم اللوحات القرآنية تخط به، وخط التعليق والشكستة – برقتهما وعذوبتهما – يتناغمان مع الموضوعات الشعرية بشكل عام، والديواني والديواني الجلي – بفخامتهما وأبهتهما – يصلحان لكتابة ما هو موجه إلى الشخصيات المرموقة، والنسخ والرقعة – لبساطتهما وسرعة أدائهما – يُناسبان المكاتبات اليومية السريعة … وهكذا …
وبعد فهذه قواعد عامة، ولكنها ليست فاصلة أو منزلة، إذ من الممكن تجاوزها … فيمكن لبحور الشعر الجزلة أن تأخذ مكان البحور الناعمة، والعكس صحيح، وفي الموسيقى – مثلاً – يجوز لمقام (الصبا) الحزين أن يستعمل في موضع الفرح، كما يجوز لمقام (العجم) المفرح أن يستعمل في موضع الحزن، وذلك بحسب براعة الشاعر والموسيقى، وقدرتهما على التأثر والتأثير.
وبالمقابل … يستطيع الخطاط الحاذق أن يستبدل أماكن الخطوط تجاه موضوعاتها تبعاً لذوقه الخاص.
الشأن كله متعلق بقوة العمل الفني – أدباً كان أو قطعة موسيقية أو لوحة خطية، وهذه القوة الفنية من شأنها أن تدخل من غير استئذان عبر بوابتي الأذن والعين إلى قلب المتلقي وعقله .. أي إلى (قلبه العاقل).
وإن قواعد أي فن أو ضوابطه – والتي لا وجود له من دونها أصلاً – إنّما وُضعت لكي تُمارس ردحاً من الزمن – عملاً وذوقاً – ثم يتجاوزها – نحو الأجمل – من يجد نفسه مؤهلاً لذلك.