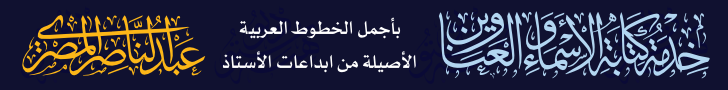(نون والقلم وما يسطرون)، أقسم الله به فكان له ما لم يكن لغيره من حظوة وقدسية، وكان له ما لم يكن لغيره من فنون العرب والمسلمين من أهمية وبذلك كانت ولادته الكبرى.
ما قيل في تاريخ نشأته كثير. ومن هذا الكثير ما يذهب بعيدا في التأويل الأسطوري، فأبو اسحق كعب بن مانع الملقب بكعب الأخبار، يذهب إلى أن أول من كتب بالعربية هو “آدم” عليه السلام، ويذهب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس إلى أن أول من كتب بها ووضعها هو إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، أما عروة بن الزبير فقد زعم أن أول من كتب بها قوم من الأوائل أسماؤهم: أبجد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت، وكانوا ملوك (مدين) ويذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف : “بأن ولادة الخط العربي كانت على يد كل من “مرامر بن مرة” و”اسلم بن سدره” و “عامر بن جدرة”، فالأول منهم وضع الصور والثاني فصل ووصل والثالث منهم وضع الإعجام، أي أزال عجمته”. وهو ما يذهب إليه “الطبري”، أما المسعودي فقد نسب نشأة الخط العربي إلى إدريس بن نوح، ويرى ابن النديم (توفي في 17/ 9/ 995) بأنه ولد في العراق ومنه انتقل إلى الأنبار وانتشر عنها، ويخالفه في ذلك ابن خلدون إذ يرى أنه ينتسب إلى الخط الحميري الشائع في اليمن ويسمى بالخط “المسند”.
وتشتت الآراء بالمؤرخين والآثاريين المعاصرين إلى اجتهادات متعددة في نشأة الخط العربي، فمنهم من يقول إنه منحدر عن الخط السرياني لما به من شبه بين حروف الخطين، ومنهم من يذهب إلى أنه وليد الكتابة الفينيقية، بينما ينسبه المستشرق الهولندي “فان دي براندن” إلى الخط المصري الهيروغليفي القائم على ثمانية وعشرين حرفاً، والذي يعود تاريخه إلى خمسة عشر قرنا قبل الميلاد، وأن الكنعانيين المقيمين على سواحل البحر الأبيض هم الذين طوروا هذا الخط وأشاعوه في الجزيرة العربية، غير أن ما يقطع به الآثاريون المتأخرون بأن الخط العربي انحدر أصلاً عن الخط النبطي ثم استقل عنه شيئا فشيئا.
إن النقوش التي اكتشفت لتدل دلالة واضحة على هذه النسبة، حيث عثر في العديد منها ما يقوم على كلمات وجمل عربية، ومن أشهر هذه النقوش “نقش أم الجمال” وقد كتب في القرن الثالث بعد الميلاد والذي منه كان الخط الكوفي، ونقش “النمارة” ويعود إلى عام 328م وهو شاهد على قبر امريء القيس، ونقش وادي “فزان” ونقش “امسيس” ونقش “حران” والذي يعود إلى عام 568م وشكله قريب من شكل خط النسخ.
ومع الإسلام أصبح الخط العربي من بعض رسالة المسلمين، فكان أن سعى المسلمون إلى كل ما يصونه من قواعد وثوابت تحد مجرى الحروف وتفترض لكل ضرب من ضروب مقاساته من ناحية، وتفتح من ناحية ثانية المجال وسيعاً لكل ما يعزز جهود المتفاضلين في تجويد الفروق حتى تآلفت مع كل الفنون والصناعات اليدوية وفي مختلف الأقطار الإسلامية فوهبته كل مادة اتسعت له ما تطورت به أشكاله وتعددت نماذج حروفه واختلفت أقلاماً وأصبح العلم بفن الخط من فضائل المتعلمين، فهو في نظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه (من أهم الأمور وأعظم السرور)، وصار للمجيدين في صنعة الخط فضل الدالين إلى الخير والإيمان يحمله كابر عن كابر وصية في عنقه ويتبارى الحكام والولاة في رعايته، كما أجمع رجال الدين على اعتباره جهداً مباركاً حتى أن عبد الله بن عباس الملقب بحبر الأمه قال في أحد الخطاطين: (.. إن رجلاً كتب بسم الله الرحمن الرحيم فأحسن تخطيطه فغفر الله له) وان الوالي. العباس عبد الله بن طاهر رد مظلمة أحدهم لأنها لم تستكمل نفسها في خط جميل (أردنا قبول عذرك فأقطعنا دونه ما قابلنا من قبح خطك ولو كنت صادقاً في اعتذارك لساعدتك حركة يدك، أو ما علمت أن حسن الخط يناضل عن صاحبه ويوضح الحجة ويمكنه من درك الغاية).
وإذا كانت الكوفة قد اعتمدت الخط الكوفي وأولته من رعايتها له ما مد سبباً لانتسابه إليها، فان مثل هذا الأمر لم يبق مقتصراً على الكوفة فقد أصبح بدعة كل قطر من العالم الإسلامي، فيوم أن عرفته إيران كان لنا منه الخط الفارسي متمثلاً بروائع لا تجارى، ويوم أن استقر في تركيا جندت له من يبدعون فيه، وحسبك من ذلك ما كان لهم من جهد إبداعي في الديواني والطغرائيات، وحين شد الرحال إلى المغرب العربي اشتقوا له من الكوفي القديم ضروباً لا تنتظمها قواعد، وإذا ما صار إلى الهند ابتكرت لنا كوفياً هندياً، ويوم أن مر بالصين أكسبته من جمال خطها ورهافة فرشاتها ما أغنت رحلة هذا الخط، ولك أن تضيف إلى ذلك اثر زخارف الأمويين عليه وغنى العباسيين وما أفاده من التأثيرات الساسانية والفاطمية والمغولية والمملوكية والسلجوقية مما فجر في هذا الخط قوة إبداعية لا نظير لها فاستقام فناً متكاملاً ما بين القرنين العاشر والثالث عشر، وفي رسالة لأبى حيان التوحيدي عن علم الكتابة يذكر من أنواع الخط الكوفي وحده والتي شاعت على أيامه إثنى عشر نوعا كالإسماعيلي والمكي والمدني والأندلسي والشامي والعراقي..الخ.
وقد كان لاعتداد العربي بلغته واعتزازه بآدابها وحكمها وذلك منذ وعي بعض مظاهر حضارته فيها، ومنذ أن كرمها الله باختيارها لغة كتابه الكريم، ومنذ أن حملت الأحاديث النبوية الشريفة من أرض إلى أرض، لقد كان لاعتداده بما تناقلته شفته من روائع هذه اللغة أن شحذ همته في أن تكون لبوس الكلمة لمسموعة على مثل مستواها في الكلمة المكتوبة، وهو ما يشير اليه الخبير بالمخطوطات العربية “مارتن لنكس” وما سبقه إليه ياقوت المستعصمي بقوله: “الخط هندسة روحانية بآلة جسمانية”. وقد ورد في مأثور كلام العرب الكثير مما يشير إلى هذا التداخل ما بين ما هو مسموع وما هو مكتوب كقول الفارابي “بان الخط أصيل في الروح وان ظهر بحواس الجسد” أو القول المأثور بأن “حسن الخط أحدى الفصاحتين” مثله قول بعضهم “الخط لسان اليد وبهجة الضمير” أو قول عبد الحميد الكاتب “البيان في اللسان والبنان” ومثل هذه الرؤية لأهمية الخط عند المسلمين هي التي دفعت به إلى أن يتخطى مهمته في الكتابة إلى نزوع أصيل في الفن التشكيلي.
أصول قديمة ورؤية جديدة
وقد بقي الكثيرون من فنانينا المحدثين أمناء لأصالته التراثية، فانتصروا للخطاط الذي فيهم، معترفين ضمناً بأن أي خروج على هذه التراثية سيفقده الجلال والرصانة والعمق الروحي الذي تآلف مع أعمال خطاطينا القدامي، ولذلك ظلت أعمال محمد سعيد الصكار وعثمان وقيع الله وحسن المسعودي وغيرهم تستمد إيحاءاتها من الأصول القديمة وتجدد فيها، فان خرجوا عنها فالي ما يتساوق معها في المزاوجة ما بين ضروب متعددة من الخطوط، تخالطها وتوصل بينها أشكال لحروف مبتدعة تكسر من حدة المفارقة وتمهد لمتجانس العناصر المختلفة وضمن تكوينات تأخذ حركتها عن طريقه واتجاه قراءة النص تأكيدا على الحركة الكامنة داخل الحروف وداخل التكوين المقام، أو في مسعى لاستغلال الإيقاعات المتشابهة لترتيب الحروف لخلق أنغام مرئية تتخللها فراغات صامتة أو ممتلئة بزخارف دقيقة، وان ما وقع لهؤلاء الفنانين من خطاطينا المعاصرين من آثار الخط المختلفة في العمارة العربية والنحاسيات والأواني والخشب والزجاج والملابس والطغرائيات أصبحت بانتقالها إلى لوحاتهم مكتنزة بمميزات جديدة، فما فرضته طبيعة كل مادة من قبل على الخط حرروه وسعوا به إلى ما يبعث بخصيصته في نمطية أخرى متحررة من اثر القماش أو شكل الآجرة بظلال استدارة الآنية أو انعكاس المرآة وما يحده بظلال متدرجة وأعماق وأبعاد مترادفة بأثر من تمرس كل منهم في قدرة الألوان على فرض هذه المسافات في اللوحة وتجاوز ظاهرها التسطيحي، وثمة لوحات لعدد من الزخرفيين العرب المعاصرين سعت لان تقترب أكثر من اللوحة التشكيلية من خلال الإفادة من النماذج الشائعة في الخط الكوفي الهندسي أو الكوفي الشطرنجي والنسج على منوالهما وبما يجرد الكلمة من معناها ويبقي على إيقاعها التكراري، كلازمة زخرفية هندسية تناسب الخطوط المزوارة للكوفي كما هي الحال في نخبة من إعمال عصام السعيد وكمال بلاطة وغيرهما.
وثمة آخرون من فنانينا سعوا إلى المزاوجة ما بين الصرامة الاتباعية للخط العربي وبين تجريدية الخلفيات التشكيلية له عبر ما استقام لهم من مقدرة أدائية في الخط والرسم على حد سواء، ومن تلك أعمال لمحمد علي شاكر الذي يستخدم فيه صورة خلفيات لونية غائمة وذات درجات متفاوتة تتخللها مساحات ضوئية ساطعة، تلتف حول كتل من حروف تتكرر على مستويات مختلفة من الوضوح والحجوم مما يؤكد جهده الإبداعي في منظور متعدد الأبعاد، وكثيرا ما يلتزم باستخدام خط “الثلث” موسعاً فراغات لتزيينات زخرفية وورقية ونقاط وحركات، وعلى مقربة من هذا المناخ محاولات وجيه نحلة الذي بقي ملتزماً لفترة طويلة باستخدام الخط التقليدي ضمن جمل مألوفة وضمن ضروب متعددة من الكوفي والرقعي والثلث، وبما يناسبها من تأطيرات زخرفية ناتئة وظلال متدرجة الكثافة لتجسد جملة وتبرز دلالاتها المعنوية وتعمق من انتسابها التراثي بألوانها وزخارفها المذهبة، مما ميز هذا الفنان بالصانع الحاذق الملم بأسرار مهنته والساعي للتبشير بها والإعلان عنها، وهو عكس ما ذهبت إليه محاولات فنانين آخرين ممن اتسعت مساعيهم للإفادة من الطبيعة السمحة لبعض أصناف الخطوط العربية الموروثة والتعبير من خلالها عن مشاعر ذاتية ومن أبرز من تمط فيهم مثل هذا التوجه إبراهيم المصلحي الذي جهد في عدة محاولات لدرس جماليات الخط العربي ومقومات تكويناته، مستخدماً كل ذلك في نمطية تجريبية يسعى فيها إلى التركيز على إبراز الطابع الحسي في شكلية الخط واندفاع حركاته فيوضح ذلك بقوله: (لقد اهتممت بالعوامل الأساسية في التكوين وخاصة الخط العربي والزخرفة حيث أعدت إلى مرجعه الأساسي كرمز لأشكال مرئية وهذا كان مفتاحاً للمجال الذي أعمل فيه الآن) وهو ما يذهب إليه زميله “شبرين” وهاشم سمرجي اللذان تذكرنا بعض أعمالهما بإبداعات الخطاطين المغاربة القدامى. ومن يتأمل فيها يجد أن هناك تأثراً واضحاً بالخط الكوفي القيرواني باستطالته وامتلاء حروفه وسماكتها وتجانس حركاتها، وحيث للكلمة فضولها في إثارة الرغبة في قراءتها واستكناه مكنونها.
الخط بأبعاده التجريدية
وفي جهد ريادي متميز سعى نجا المهداوي إلى استخدام الخطوط العربية ضمن نمطية مألوفة، حتى إذا ما حاولت أن تتلمس نفسك في غاية من كلمة مقروءة فلن تقع إلا على إشكال لكلمات جردت من خصائصها المعنوية وفرغت من أية دلالة، وليس ما يذكرك بالكتابة غير نسجها الخطي وغنى حركتها وانسيابها، بعد أن ألقى بها خلفية لأشكال كبيرة تتقدم اللوحة وتبدو أحيانا وكأنها كتبت بعفوية، وأحياناً تبدو مصممة من ضروب من الخطوط الموروثة على مثل ما هي في الكوفي أو الديواني أو الثلث دون أن تحمل بذاتها معنى لكلمة أو لجملة، فهو كما يقول يسعى إلى أن (يفرغ الحرف من معناه ويكف عن حمل أي خطاب) وقد صار لهذا التوجه مريدوه الكثر، وعلى مسافات متباينة من وضوح القصد في الكلمة والجملة أو التأكيد على شكل الحروف.
 وثمة آخرون سعوا لأن يتخذ الحرف أبعاداً تجريدية ضمن نزوع الكثيرين منهم إلى الإفادة من مقومات الخط العربي الكلاسيكية وأبعاده الفكرية والروحية لتطرحه ظاهرة بينة تجمع فيما بينهم وتغذي طموحاتهم في العمل فيه، وذلك ما نبهت إليه الناقد الألماني”دسيجريد كالا” عند مشاهدتها لمعرض السنت ير الذي أقيم ببغداد عام 1974.، إذ قال: “…لعلني لا أغالي كثيراً، فمن جميع ما شاهدته في البينالي العربي لم أجد نتاجاً يفصح عن مصدره العربي وينطق به إلا ذلك الإنتاج الذي يتصل باللغة، أي الذي يتخذ من فن الخط العربي والحروف مادة له” ويضيف إلى ذلك ناقد أوروبي آخر هو “روبير فرنيا” بقوله “… أصبحت الكتابة تخفق فيها الحياة وتصبح أكثر طراوة وأكثر صلابة، تركض في سطورها المتساوقة أو تتشكل في قوالبها الهندسية، مما يمكن للخط الكوفي أن يتخذ ألف شكل وشكل وأن يعطي دلالات جديدة لأساليب عديدة للوصول إلى أن تصبح ضرباً من القراءة في المستحيل وتصير الوظيفة الزخرفية عملية تأملية أو تربوية قريبة من الصلاة “.
وثمة آخرون سعوا لأن يتخذ الحرف أبعاداً تجريدية ضمن نزوع الكثيرين منهم إلى الإفادة من مقومات الخط العربي الكلاسيكية وأبعاده الفكرية والروحية لتطرحه ظاهرة بينة تجمع فيما بينهم وتغذي طموحاتهم في العمل فيه، وذلك ما نبهت إليه الناقد الألماني”دسيجريد كالا” عند مشاهدتها لمعرض السنت ير الذي أقيم ببغداد عام 1974.، إذ قال: “…لعلني لا أغالي كثيراً، فمن جميع ما شاهدته في البينالي العربي لم أجد نتاجاً يفصح عن مصدره العربي وينطق به إلا ذلك الإنتاج الذي يتصل باللغة، أي الذي يتخذ من فن الخط العربي والحروف مادة له” ويضيف إلى ذلك ناقد أوروبي آخر هو “روبير فرنيا” بقوله “… أصبحت الكتابة تخفق فيها الحياة وتصبح أكثر طراوة وأكثر صلابة، تركض في سطورها المتساوقة أو تتشكل في قوالبها الهندسية، مما يمكن للخط الكوفي أن يتخذ ألف شكل وشكل وأن يعطي دلالات جديدة لأساليب عديدة للوصول إلى أن تصبح ضرباً من القراءة في المستحيل وتصير الوظيفة الزخرفية عملية تأملية أو تربوية قريبة من الصلاة “.
وقد سعت جماعة “البعد الواحد” في العراق ومنذ أوائل السبعينات أن تستكمل نفسها في منهجية واضحة عبر محاولة الفنان شاكر حسن آل سعيد في إيضاح غاية زملائه في التجربة بقوله “.. أما بالنسبة لنا كمستلهمين للحرف في الفن، فإن موقفنا سيعتمد على إدراك هوية التراث العربي الراهن الذي نضعه عبر اقتباس أهم عنصر من عناصرنا الحضارية والفكرية وهو الحرف العربي.. إذن فان الدور الذي سنلعبه هو وضع اللبنات الأولى لمدرسة معاصرة في الفن تعتمد على استلهام الحرف”.
وعلى الرغم من أن الجانب التنظيري لم تنهض به رؤية واضحة وشاملة حتى الآن، فان جهود الفنانين العرب في بيان الإبداع التشكيلي الحرفي والتناظر في أساليبهم والتباين بها قد عزز من خصوصياتهم، فما كان قد بدأ في أواسط الأربعينات مع التجربة الرائدة للفنانين العراقيين “مديحة عمر” و”جميل حمودي” في استخدام الحرف ضمن محاولات متساوقة لحد ما مع النزوع التجريدي الأوروبي، ظل يشكل مسرى للعديدين من فناني الوطن العربي على مستويات مختلفة واستلهامات متعددة المصادر وبحيث يظل الحرف كما هو عند مديحة عمر لا يعكس ظاهره الشكلي بقدر ما يعكس انطباعات الفنان عنه وانفعاله به، فهو يوحي به ولا يدل عليه، ويحاول محمود حماد أن يعزز من تجربة سلفه أدهم إسماعيل في أوائل الخمسينات والتي تقوم على استخدام النسيج الكتابي في كتل لونية تسحق الفراغ المحيط بها، وتفقد في ذات الوقت مكوناتها في اللغة أو في الحرف الذي يرغب في أن يرصد قدرته التشكيلية مما يبقى محاولته دون طرحه في قوله: “إن الخط العربي عنصر تشكيلي وتجريدي يمكن الاعتماد عليه لانجاز أعمال فنية تستند إلى عنصر تراثنا بدل الاعتماد على الأشكال التجريدية المحضة المستخدمة في الفنون الغربية”. ولعل أبرز الصيغ التي تشذ بين محاولتي أدهم إسماعيل ومحمود حماد نزوعهما إلى استخدام حركة الخط العربي الموحية بلا نهائيته، واستغلال العناصر التشكيلية التي في الحرف لملء مساحة اللوحة كلها وبانتقالات لونية متجانسة، ويمثل هذا الأسلوب كانت بدايات جميل حمودي، إلا أنه أكثر ميلا إلى حصر فراغات اللوحة بحركة الحرف التي أثقلتها كثافة ألوانه فتحولت إلى أسيجة لا تخلو من إيهام درامي من خلال تقليص الفرصة أمام أي نمو في مساحات الفراغات، وقد نجد النموذج المتطور عن مثل هذا التوجه وبشكله المتميز في أعمال الفنان التونسي نجيب بلخوخة الذي يداخل أحياناً وبقدرة مرهفة ما بين الإيقاعات المعمارية وإيقاعات الحروف العربية.
ولفناني المغرب مسعاهم في التعامل مع الحرف العربي بنزوع تجريدي مرتبط بإطار تراثي كالإيحاء بصفحات من مخطوطات قديمة أو استلهامه من خلال إيقاعات هندسية للخط الكوفي وبأسلوب يحاول فيه الفنان تجاوز حرفيات اللغة وذلك بغية خلق شيئيات جمالية لا يكون للحرف أو الخط فيها ما يتمايزان به من الأشكال الأخرى المطروحة في اللوحة والمتنكرة للبوسها في الواقع الظاهري حيث يصبح لانعكاس الألوان عليها وتدرج إيقاعاتها الأهمية الأولى التي تخلق منها مناخاً سحرياً يسترجع فيه الحرف بداياته المبهمة، وتختزل تجربة أحمد الشرقاوي الكثير من محاولات مريديه المندفعة ضمن مفهومه “.. أن يكون الفنان تجريدياً لا يعني تحويل التطابق الاحتمالي بين الأشياء الطبيعية إلى تجريبات ولكنه يعني أن تتحرر بغض النظر عن التطابق الاحتمالي العلاقات القائمة بين الأشياء” فرؤية الحرف واضحاً في هذه الحالة وسبر مدلوله المعنوي لا قيمة لهما في نظره لأنهما يعوقان اللغة عن كشف نفسها، والتي هي أبعد من شكل الأشياء أو شكل الحروف لأنها اللغة “الخالصة لما هو مرئي” ويفقد الشكل أي صلة ممكنة باللغة من خلال الصفة الظاهرة للحرف أو الكلمة وإذا كان لحرف ما إن بدا على قدر كبير من الوضوح والدقة التراثية كما هي الحال مع بعض أعمال محمد المليجي فإنه ليس بأكثر من اقتباسات شكلية كما تقول عنه طوني مارتيني وذلك “… لخلق انسجام فني مقبول بين الخط العربي. والأشكال المضادة كلياً للخط المستخدم”.
وتتسع قائمة الفنانين المستوحين للخط العربي والحرف العربي لعشرات وعلى امتداد المشرق العربي والمغرب العربي، ولكل منهم نزوعه لاستحداث خصوصيته فيه، وعبر تحولات ومحاولات مختلفة لا يستقر عليها، إلا لفترة وجيزة ثم ينتقل منها، حتى أصبح من الصعب جداً رصد تلك التحولات وتقويم أهميتها لسرعة ظهورها وسرعة اختفائها، ويمكن أن نشير في هذا المجال إلى مسعى أحمد فؤاد سليم في المجانسة ما بين الطبيعة الأفقية للخط العربي والإيقاعات الرأسية المنبثقة منها، أو مسعاه لتعميق الإحساس بلولبية أشكاله المقتبسة من الحرف. والى ما جد من جديد في محاولات الفنان حسين ماضي التي تسعي إلى أن توحي بأبجديات على مقربة من الحرف العربي وأبجدياته، وتتخذ من خلالها إيماءات طقوسية لا تخلو من مناخ سحري لولا شدة الإتقان البارزة على أسلوبه وشدة الإيحاء بالإيقاع المكرور لتلك الأبجديات ويعد الفنان اللبناني سعيد عقل أحد الفنانين اللبنانيين الأوائل الذين تعاملوا مع الحرف في مثل هذه الصيغ التجريدية الأوروبية، ثم كان أن تحول عنها لإيمانه بأن إمكانيات استخدام الحرف توفر له أبعد مما توفر للفنانين الأوروبيين في هذا المجال، وأن كل جهد فيه هو “انتصار لشكلياته وبذلك يتدنى عملنا فيه عما كان للفنان الإسلامي والعربي الذي سبقنا إليه وأدركه في صميم واقعه اللغوي والزخرفي والاجتماعي والروحي”.
وما ارتد عنه هذا الفنان استفز طموح شاكر حسن آل سعيد “لأن التكملة المنطقية للعالم لا تكتسب في اللوحة إلا عندما يفقد الحرف صلته باللغة” والى حيث يصير الحرف واللفة والتدوين “مجالاً لافتعال حركة ذهنية وزخم روحي يفيض بكل المعطيات في حضارتنا العربية المعاصرة “.
ويبقي رافع الناصري المناخ التجريدي مسيطراً على أجواء لوحته حيث يأخذ الحرف فيها مركز الاهتمام وحيث تنجذب إليه كل الكتل والحجوم المحيطة به وبأسلوب متميز بالدقة والتوازن الشكلي واللوني محاولاً في الوقت ذاته أن يفاد عبر وضوح الحرف من تداعيات الجرس الصوتي المسترجع في الذاكرة بالإضافة إلى طواعية شكله ليخرج بهما إلى ما يعزز قوة تأثيره، فهو إذ يرسم حرف “السين” يؤكد على سن أطرافه كأنه يسعى لأن يفجر تداعيات ذهنية ترافقه في “السيف” أو “السنان” أو “السكين” أو “السهم” ويفرض من خلال قدرة هذا الحرف بجرسه الصوتي أو بتداعيات الكلمات التي يستنبطها أو برؤوس شكله المسننة على تمزيق مكونات اللوحة، بمعنى في الرمز الذي اختزله الحرف ويخلق بذلك توافقاً ما بين مجرى الذاكرة العينية ومجرى الذاكرة السمعية، فهو إذ يوضح شكل الحرف إنما يفرض عليك أن تلفظه أو تهمس به ليصل بك إلى حيث “يبقى الحرف في الصورة رمزاً مطلقاً”، والرمز في هذا الإطلاق يتحدد أثره بقدرة المتلقي على التنفس في مناخ خصوصيته وتلمسه بالحدس كمنظور معنوي متشبث في بعض الأحيان برقم أثري يمد به إلى بعد تاريخي ويقابل منظوراً تشكيلياً. وما لم ندركه في ذلك فقد لا نقع لغير واجهته التزيينية الساذجة، إذ أن لبعدي اللوحة التاريخي والتشكيلي ما يمد الحرف بزخم إيمائي بمعنى في الرمز الذهني المنبثق من واقعه التشكيلي في اللوحة:
الكتابة في اللوحة الحديثة
أقول الكتابة تمييزاً لها عما نعنيه بالخط وتأكيداً لتلك العفوية التي تتسم بها، ويمكن أن نؤرخ لهذا التوجه عند فناننا العربي بمحاولات الفنان جواد سليم في الخمسينات عبر مسعاه لاستلهام التراث التصويري العربي برؤية جديدة، حيث كان أن تسربت إلى بعض لوحاته الجمل التفسيرية وعلى غرار ما ألفناها في رسوم المدرسة البغدادية وصور الواسطي لمقامات الحريري وكتب العلم والفلك والطب والأدب، وضمن مواضيع تتواءم مع أسلوبه الأدائي فتتأكد بذلك تراثية لوحته موضوعاً وأداء كما في لوحته “مكر النساء” والتي تطرح الكتابة فيها نفسها ضرورة تنبع من صلب مقومات اللوحة.
وقد تواصل مع جهد جواد سليم في هذا المجال أخوه نزار سليم، وثمة آخرون كانت تبدو مثل هذه الجمل التفسيرية أو التعليقات من حين لحين على أعمالهم مثل كمال بلاطة وخميس شحاته وعبد القادر الأرناؤوط ويوسف أحمد وعبد الله الحريري ولطيفة التيجاني وعلي الرزيزاء وأثيل عدنان وآخرين.
وفي جهد متميز في بابه استخدمت صبيحة الخمير الكتابة العفوية في استنساخ قصيدة الشاعر التركي ناظم حكمت المترجمة للعربية “السحاب العاشق” إذ راحت تداخل ما بين النصوص والتخطيطات بكثير من التدفق الحيوي الذي جعل من الكتاب كله دوامة من الكلمات والتشكيلات الملتفة على بعضها البعض وحيث لا تقف الكلمة عند صورة ما الا لتصير بديلاً لكلمة غفل عنها الشاعر.. وهو توجه تقترب منه أثيل عدنان في لوحاتها القائمة على مزاوجة ما بين نصوص شعرية كتبت بعفوية وصور رسمت بأسلوب مماثل وعلى أرضية ذات ألوان شفافة. وثمة من استخدم الكتابة ضمن تشكيلات زخرفية كعادل الصغير وعبد الحي مسلم وضمن احتفاظهما بالدلالات المقروءة التي غالباً ما تتخذ لها إطارات تشد بها إلى إشارات محلية، فكمال أمين عوض يجاور ما بين الحروف العربية المتوزعة على أطراف الأشكال كنقوش محفورة وبين أشكال تشخيصية ذات طابع رقمي أو أثري ليمد ما بينهما ببعد زمني يشير إلى خصوصية بيئته المصرية وفنونها التراثية. ومن تلك المحاولات ما تسعي لأن تنهض في رؤية واضحة عند نخبة من الفنانين الشبان تعود بهم إلى استلهام أسلوب الرسم بواسطة الحرف وبما لا يخرج عنه بشيء جديد كما هو الأمر مع أعمال أحمد عز الدين حيث يؤطر الجمل المقروءة في تجسيدات لأشكال طيور أو ما يشابهها، وعلى كثير من المباشرة والوضوح.
وتذهب محاولات عدد من الفنانين العرب المحدثين إلى الإفادة من التاريخ المحلي لبلدانهم، فالفنان اليمني علي الغداف جنح إلى توظيف الحروف الحميرية والنقوش السبئية في لوحاته وضمن عينات من الفنون الشعبية الشائعة في محيطه، والفنان الأردني رفيق اللحام زاوج في بعض أعماله ما بين الخط العربي والخط النبطي، وقد صار لهذا التوجه مريدوه الكثيرون بغية تكثيف الوعي بالعلاقة القائمة ما بين مختلف الأدوار التاريخية التي مرت ببلدانهم، وفي مسعى لتثبيت خصيصة جديدة تستمد هويتها من هذا التمازج ما بين الحرف العربي والرمز المحلي والمنبثق من خصوصية تاريخه.
وتختزل تجربة الفنان ضياء العزاوي مع الحرف العربي أهم إمكاناته، اذ أدرك الكيفية التي توظف بها أشكال حروفه وكلماته ونصوصه الشعرية لخدمتها التعبيرية، فقد يشد بكلمات إلى دوامة صاخبة من الحروف المبتورة الأطراف والمندمجة بالأشكال المحيطة بها من مثلثات ورؤوس أسهم وأهلة، وضمن ما تحمل كل منها من دلالات رمزية تعود بها الى تواريخ مختلفة ومتباينة حتى لتكاد تشعر بالزمن يخترقها جميعا وينتظمها بعضاً إلى بعض، فبقدر ما تشعر بأشورية اللوحة تشعر بإسلاميتها وتشعر بمعاصرتها، بل يصبح الزمن نفسه منظورا إيهامياً في العمل التشكيلي ويصبح الحرف إشارة كما يقول: “..يتسلق حافة التجربة ليحقق من خلالها وحدته التي تكتسب شرطيتها في الوجود الجديد له” وهو إذ يستعين بأية كلمة أو بأية جملة أو نسيج حروفي، لا يأتي بها من الخارج لتلتصق بمكونات لوحته كما هو الأمر عند الكثيرين من فنانينا، بل يعمد إلى أن يجعل كل حرف فيها يبحث عما يتم معنى الكلمة أو يطرح مغزى لها من خلال حرف رديف له، فالحرف عنده مرمى في هدف سواء أجاء وحده أو في كلمة أو في مقطع شعري يحاور الحجوم المتوزعة في اللوحة بلغة تتواءم مع حساسيات الجزئيات المنتشرة فيها، وهو ما طرح منهجه الأدائي أسلوباً متميزاً صار له مريدوه ومقلدوه وعلى الأخص النازعين نزوعه الى اقحام أقصى امكانية تعبيرية في اللوحة ومن خلال مضامين متعددة ورموز مختلفة تتلألأ ببريق واضح في مركز الإثارة من اللوحة، وأن هذا الوجود الجديد للحرف عند العزاوي يحاول أن يحقق ذاته بمزيج من واقع شعري وواقع درامي يتداخلان عبر إيقاعية سريعة منفعلة بتشخيصات لوحاته، فإن دل الأول على ترابط الأحداث وتزامنها فان الثاني منهما يؤكد على كثافة الإحساس بالحدث، وفي العديد من أعماله الأخيرة التي اعتمدت على استلهامات شعرية قديمة وحديثة، نجده يؤكد على وحدة الجزئيات واستقلالها من ناحية. ومن ناحية ثانية يؤكد على تماسكها واندماجها في شمولية اللوحة بحيث يفرض على المتأمل فيها أن يتحرك أمامها حركتين مترادفتين، فيقترب منها لحد السعي لقراءة الكلمات واستيعاب مناخها الشعري، ومن ثم الابتعاد عنها إلى حيث تصير الكلمات والنصوص الشعرية والحروف المتناثرة جزءا من كل، أي يفرض عليك تفكيك اللوحة تارة وإعادة صياغتها تارة أخرى، وهو ما يشكل حدثا في تاريخ التعامل مع اللوحة وتحديد المسافة ما بينها وبين متلقيها.
ولشاكر حسن آل سعيد مساعيه الحثيثة واجتهاداته الفكرية لإدراك الحرف العربي في أدق خصوصياته الروحية وانه يسعى لأن يفجر تلك الخصوصيات من الداخل ولذلك لم تستأثر القيم التزيينية للحرف باهتمامه مطلقاً، فهو ضد الخط كتصميم وضده كنسيج زخرفي، انه يعالجه من خلال النواميس الخفية التي تحرك دوافع الإنسان للإبداع، وهي دوافع ترفض أي طابع جامد أو تقليدي وان تراثية الحرف العربي عنده تنبع من كونه إنساناً تراثياً وليس من كون الحرف صورة تراثية، إنها كتابة تستدير وتلتف وتنحني وتتأزم بعصبية وتجتاح الفراغات بانفعال، ولذلك نواه يلتزم غالبا بالخلفيات ذات الألوان المتدرجة والباهتة بحيث لا يكون لها أن تحد من حركة كتابته بكتل لونية صلبة، أو تقطيعات هندسية ويبقى شكل الكتابة لا معنى الكلمة هو الوسيط الحي لعمله. إن الحرف في صوره يسعى لأن يحقق وجوده بأبسط أشكاله المتمثلة في كتابة الأطفال الاعتباطية حيث الرغبة التعبيرية تنقل تشنجاتها إلى شكل الحرف بعفوية لتشير إلى ما وراء الحرف أو الكلمة من انفعال خاص، و كثيراً ما يحاور جمله وكلماته بشقوق في جدار عتيق ليمزق ما بين بعدين زمنيين. زمن يتأكد في الموضوع المنبثق من نص الكلمة وزمن للتأمل فيه كزمن معنوي يوجز بعد اللوحة الذهني والصوفي، وان تجربة شاكر حسن آل سعيد مع الحرف كضمير خفي لأي عمل كتابي عفوي تشكل مسارا على جانب من الأهمية بعد أن أصبحت قضية الكتابة شغله الشاغل منذ عام 1970. وهو في سبيل إدراك قدرة الحرف التشكيلية وأبعاده الصوفية وانتهاء بمحاولاته الأخيرة في استخدام الجمل المبتورة بغية تعميق المشاركة ما بين طرفي العمل الإبداعي في الفنان والمتلقي.
وثمة تجارب مختلفة تقترب من المناخ العام لأعمال شاكر حسن آل سعيد من حيث استغلال السطح الجداري للكتابة المعنوية، وربما بتأثير منه أو بتقليد له أو بمحاولة للخروج عنها بالمزواجة ما بين الكتابة العفوية وبين النماذج الخطية المزواة والأشكال الهندسية الصارمة. وهناك من ذهب إلى استخدام المشاكلة ما بين حلقات الذكر والرقص الصوفي المتميز باستداراته الرشيقة وإيماءاته وبين إيقاعات كلمة “الله” وعلى خلفية لونية شفافة بغية إعطاء الحركة ما يوحي بوقعها للحرف ما ينسجم معها باندماجها بكافة جزئيات اللوحة تأكيداً للدلالة الموصلة ما بين الموضوع والخط المتلاشي فيه، ويستغل رفيق شرف الأساليب المتوارثة في كتابة الطلاسم والأدعية فيماثل ما بين تشكيلاتها الكتابية وبين تقنيته المتميزة، وبذلك يحافظ على مناخها الروحي وتراكبيها العفوية، من ناحية ومن ناحية أخرى لا يهمل الإيحاء بإمكاناته الأدائية.
الخط يتخطى إطار الصورة
لقد حفز شيوع استخدام الحرف في الرسم الحديث واندفاع غالبية الرسامين العرب المعاصرين إلى التفاضل به فيما بينهم، حماسة التشكيليين الأخوين إلى الاستعانة به في أعمالهم الإبداعية وعلى مثل ما انتقل بالأمس من حيز إلى حيز ومن مادة إلى مادة حتى أن بعض المعماريين قد أخذت تراودهم فكرة إقامة منشآت معمارية تقوم على أشكال لكلمات وحروف عربية، ولكن ما تحقق فعليا من هذه الجهود المتفرقة ظل محصورا بنخبة قليلة وتبدو على جانب كبير من الضالة إذا ما قورنت بما شاع منها في مجال التصوير. إلا أنها نخبة تتيح لنا أن نطمح بما يعززها في المستقبل.
فمع النحات محمد غني حكمت يفتح الحرف العربي أفق ريادة جديدة في حفرياته الخشبية وبعض أعماله النحتية إذ يفرض عليه كينونة خاصة تتمثل بمسعاه لأن يبعث الحرف من شكل جامد إلى شكل متسم بسرعة حركته وذلك بما يضيف عليه من تحويرات ضمن سيولة الحرف العربي، مستلهما الكثير مما أورثته اياه فنون القطر العراقي في مختلف العصور، ومن حيث السيطرة على الذهن بتأكيد التكرار عبر تآلف جماعي لا يسمح لأي شكل من أشكاله أن ينفرد بنفسه، وضمن وعي فنان متمرس على تحقيق دقيق للتناسب والتناظر ما بين الحروف المتداخلة والفراغات المحيطة بها، والتكافؤ في ثقل الأشكال وتوازن بعضها مع بعض والاقتصاد في حركة كل منها انسجاماً مع توترات حركة العين وبين وحدة التنوع وامتلائها بحسية متخمة بالحركة اللولبية المتدفقة، فالحروف كما يقول:”كالحياة معنى لا ينضب في الاستلهام الذاتي لتجريد المعاني” وهو إذ ينزع هذا النزوع التجريدي الذي لا يبقى فيه من الحرف العربي غير الإيحاء بسيولته وطواعيته للتمحور والامتداد إنما يفعل ذلك برغبة في تحدي تعسف المكان عبر إيقاعين يتابع أحدهما الآخر متابعة الظل للشيء المتحرك ليصير لنا منهما واقع لوحته الجمالي بعد أن حور في شكل الحرف وداخل ما بينه وبين آخر يليه، والى الحد الذي يمحي فيه كل ما يشير إلى هويته أو إدراكه في معنى أو حتى في شكل معين للحرف، انه يذكرك بطبيعة الخط العربي الذاتية مع إلغائه لمقومات الخط في الحرف أو في الكلمة.. ومثل هذه المحاولة تتواصل مع محاولة للدكتور محمد وجيه في استخدامه للقضبان الحديدية والأنابيب الرقيقة والدقيقة لإيجاد تكوينات تجريدية تستعير من الخطوط العربية غير المزواة، مرونتها وقدرتها على الالتواء والانحناء والاستمرار بدون انقطاع وعلى غير غاية في حرف أو كلمة أو جملة، وتلعب المصادفة المقصودة دورا رئيسيا في مثل هذه الأعمال بما تستبطن من كشف عابر يستعين به الفنان من خلال متابعته للعمل، بينما العمل عند محمد غني حكمت يقوم على العديد من التخطيطات المصحوبة بدرجات مز التظليل التي يسعى بواسطتها إلى إبراز مدى تأثر محفوراته باختلاف مساقط الضوء عليها، فأداة عمله في البدء الرسم الذي يتيح له من خلاله حل إشكالات التماثل والتقابل وضبط إيقاعات التكرار وكيفية نمو تدرجات الإضاءة ووقعها على العناصر الحرفية وأرضيتها خاصة وان النحات محمد غني حكمت قد استخدم هذا النسيج الأدائي في عدد من الأبواب الخشبية التي وعى فيها اثر حركتها نصف الدائرية على مختلف مكونات عمله.
وقد مد الحرف بعنقه إلى أعمال الكثيرين من الخزافين المعاصرين بنزوع يخرج به من التوظيفات القديمة في المواد النفعية المألوفة إلى جهد يتكامل في أشكال فصبية تستمد أبعادها من طبيعة الحرف العربي الذي ترده (يتحرك وهو جامد) ولعل من أبرز من تفرغ لمثل هذا الجهد المتميز هو الخزاف المصري محمد الشعراوي الذي عرف كيف يوازن بين الفراغات لتأكيد أشكال الحروف وكيف يستوحي طرز العمارة اليمانية لإقامة زخارف بسيطة تتداخل مع الأشكال وتوحي بمقوماتها الواقعية والاجتماعية.
وهكذا فان العديد من المحاولات الناجحة للفنانين العرب المحدثين في مجال استلهام التراث والحرف العربي والتعبير عن واقع الإنسان العربي المعاصر تؤكد أنهم سعوا فعلا لمعايشة عصرهم من خلال تراثهم ومعطياته وبما يعمق التواصل بينهما.
مجلة نزوى – سلطنة عمان – العدد الثامن أكتوبر 1996