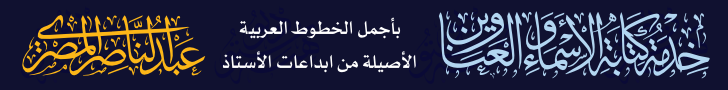عندما تتزاحم عليك التفاصيل، تتفتح كل نمنمة عن ممالك وملوك أو تمسك بتلابيبك الألوان والأصوات، وتحوم حولك الوجوه والعبارات.. خذ عين الطائر ثم حلق عالياً لترى هذا العالم الذي استأنسه العربي واستدرجه إلى الحرف.
قال “ابن عباس”: “الخط لسان اليد”! وقال “علي بن أبي طالب”: “الخط الجميل يزيد الحق وضوحاً”. وهكذا فإن فصاحة اللسان تتطلب فصاحة اليد، والحق يحتاج في إقناعه إلى الجمال.
وإذا كان القراء قد اهتموا بتجويد القرآن وتعدد قراءاته فقد اهتم الكتاب أيضا وبالدرجة نفسها بتجويد الخط وتعدد أنواعه.
وقد بلغ من اهتمام النبي عليه السلام بالكتابة أنه كان يطلق الأسير من الكتّاب إذا قام بتعليم عشرة من أولاد المسلمين القراءة والكتابة.
اكتسب الحرف العربي في عناقه مع القرآن قوة إيمانية هائلة. يقول “أرنولد توينبي” المؤرخ الإنجليزي الشهير: “لقد انطلق الخط العربي الذي كتب به القرآن غازياً ومعلماً مع الجيوش الفاتحة إلى الممالك المجاورة والبعيدة، وأينما حل أباد خطوط الأمم المغلوبة”. فكتب به الإيرانيون لغتهم الفارسية، وكتب به الهنود لغة الأوردو، كما كتب به العثمانيون لغتهم التركية، ومنذ قرر الخليفة “عثمان” نسخ القرآن، وإرسال مصاحفه السبعة إلى أطراف الإمبراطورية الإسلامية، أصبحت كتابة المصحف نوعاً من التبرك، وطقساً من طقوس العبادة، حتى أن “ابن البواب”، وهو واحد من رواد الخط العربي، نسخ بيده أربعة وستين مصحفاً، وبلغ عدد المصاحف التي كتبها “الحافظ عثمان” التركي (107) مصاحف.
في البدء كانت “الحيرة”
سوف تدهش، مثلي، للتفسيرات التي تطوع بها القدماء، لظهور الحرف العربي، هناك من يقول إن ملوك “مدين” هم الذين وضعوا الحروف العربية، وضعوها حسب أسمائهم: أبو جاد “أبجد” وهواز “هوز” وهكذا “حطي” و”كلمن” وهلم جرا. وهناك من يقول: بل أولاد النبي “إسماعيل” هم الذين وضعوا الحروف، ويصل الأمر إلى حد القول بأن عبداً ضخماً هو “ابن إرم بن سام بن نوح” نزل بالطائف، وكان أول من كتب العربية.
ولكن للبحوث العربية رأياً آخر. فمن المؤكد أن أقدم أشكال الخط العربي مشتق من الكتابة النبطية، والنبطيون عرب كانوا يعيشون في شمال الجزيرة العربية، ولأسباب تتعلق بالنشاط التجاري استعملوا اللغة الآرامية، واستخدموا نوعاً من الخطوط الآرامية في الكتابة. ولكن الغزو الروماني في أول القرن الثاني جعلهم يبدأون في إحلال لهجتهم العربية في النصوص المكتوبة بدلا من اللغة الآرامية، كما بدأت الأبجدية النبطية منذ تلك الفترة في التحول إلى الأبجدية العربية. ويتضح ذلك من خلال النقوش النبطية في “سيناء” والتي يرجع تاريخها إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديين، فالنصوص ذات لهجة عربية قديمة، متأثرة بالآرامية، ومكتوبة بالأبجدية النبطية، أما مميزات وخصائص الكتابة العربية؛ فقد ظهرت في نقش “زيد” (512 م) ونقش “حران” (568 م) وكلها مكتوبة بلغة عربية نقية.
وقد نشأت الخطوط العربية من شكلين رئيسيين الأول: من الكتابة المحفورة على مواد صلبة، ويتميز بصلابة خطوطه، ومن هذا نشأ الخط الكوفي الذي تميز بتنظيمه الهندسي، وقد تعلمه العرب من العراق، وكان يعرف قبل الإسلام بالخط ” الحيري” نسبة إلى الحيرة، وهي مدينة غرب العراق، بنى المسلمون “الكوفة” بجوارها. أما الثاني فهو الخط “النبطي” وكان أكثر ليونة ورشاقة من الخط الكوفي. هذان الخطان إذن – النبطي والكوفي – هما أصلا الخط العربي.
ولكن من الذي أطلق على “الخط الحيري” اسم الخط الكوفي؟
لقد تأخرت التسمية حتى القرن الرابع الهجري، وورد الاسم لأول مرة في كتابات “أبي حيان التوحيدي”.
كانت آلة الكتابة هي القصب “البوص” تقطع بنظام معين، وزاوية معينة، وقد قام “قطبة المحرر”، في القرن الثالث الهجري، باختراع قلم “الجليل الشامي” وهو قلم عرضه عرض 24 شعرة من شعر ذيل الحصان، فأصبح مقياساً للأقلام كمقياس الذهب 24 قيراطاً ومن قلم “الجليل الشامي” تفرعت الخطوط.
حمولة الحصان
قال “ابن مقلة” : “شكل الحروف مأخوذ من شكل الدابة”!، ربما كان السبب في اختيار العرب للحصان كمصدر جمالي للحروف أن الحصان العربي قد جمع المثل الأعلى للجمال، ويقال إن الله تعالى بعد أن أنهى الخليقة سأل “آدم” عليه السلام عن أجمل مخلوقاته فأجاب: الحصان. فالحصان يوحي من ناحية التعبير الجمالي بالقوة والنعومة معاً.
و”ابن مقلة” يرى أنه لقياس “وزن الخط” يجب الاعتماد على الخط المستقيم والدائرة، ويقول: “الألف يجب أن يكون مستقيماً، غير مائل إلى استلقاء، أو انكباب، وليس له مناسبة إلى حرف طول أو قصر”. ويقول عن حرف الراء: “هو شكل مركب من خط مقوس هو ربع محيط دائرة قطرها الألف”، وعن النون “شكل مقوس هو نصف دائرة”. إذن فأساس ضبط ووزن الخط هو الخط المستقيم الممثل بقطر دائرة، وهذا القطر هو الألف. ولتحديد هذا القطر ذكر في “إخوان الصفا”: ” إن مساحة الألف في الطول تكون ثماني نقط من القلم الذي تكتب به ليكون العرض 1: 8 من الطول”. فإذا رجعت، كما فعلت أنا، إلى مقالة النسب للجسم الإنساني عند “ليوناردو دافنشي” فستجد أن طول جسم الإنسان المثالي هو ثماني مرات طول رأسه!.
هناك عدة أشكال لحروف الحاء والجيم والخاء منها الحاء اللوزية، واللوزة كما تعرف مؤلفة من قوسين، وهي في تشكيلها على هذا النحو تشبه تماماً عين الفرس الأصيل، وحرف الهاء، مأخوذ أيضاً من جسم الحصان، وهي تتألف من قسمين: الأول يشبه الخصية والثاني يشبه الأذن. وهناك شكل آخر للهاء مأخوذ من منخر الحصان. أما حرف العين فله ثلاثة أشكال: صادية وثعبانية ونعلية والمقصود بالنعلية التي تكون كما في اسم “علي” مثلاً لأن شكلها مأخوذ من شكل نعل الفرس.
شجون الحروف
للحروف قيمة قدسية سرية، نراها واضحة في القرآن، عندما تبتدىء بعض السور بها مثل: ياء سين، نون، كاف هاء ياء عين صاد، وهناك أقدار مرعية للحروف، هناك درجات، وقوى لكل حرف، ومدلول سحري، فالباء لها حرمتها لأنها أول حرف في القرآن “بسم الله” وللألف أهمية خاصة جداً لأنها في مقام “أحد” فهي رمز للوحدانية المطلقة. يقول “سهل التستري”: “الألف أول الحروف، وأعظم الحروف، وهو الإشارة إلى الله الذي آلف بين الأشياء، وانفرد عن الأشياء”.
وقد سمى “الحلاج” ديوانه الغامض المليء بالأسرار والكشوف، “كتاب الطواسين” والاسم جمع للطاء والسين، وهي حروف يرى أن لها قدراتها الخاصة. أما علماء اللغة فيرون أن للحروف دلالات مختلفة، فالراء في الكلمات التالية: جر – فر – كر، إلى آخره لها صورة الحركة، كذلك شأن الدال في مد – عد – ود – رد، ففيها جميعاً معنى البذل.
كما استخدمت الحروف كأداة بلاغية في حد ذاتها، فاستعملت للكناية، فالجيم كناية عن الصدغ، والصاد كناية عن العين، والميم كناية عن الضيق. ومازال الحرف العربي يبوح!! فقد أعطى العرب للحروف قيمة حسابية فكانت كالتالي:
وقد استعمل هذا الحساب في قراءة الطالع وعمل الأحجبة والأعمال، كما استخدمه الشعراء في تأريخ الأحداث الكبرى، والولادة والوفاة، أو عند بناء المساجد والقصور، وأطلقوا على هذا النوع اسم “حساب الجمل”. أيام المماليك أسرف أحد الحكام في الاستبداد والظلم فقام الشعب بحرقه حياً، وقال الشاعر يؤرخ هذا الحدث الفريد:
حرقه بالنار نور وهو في التاريخ: ظلمه
فيكون تاريخ حرق الظالم هو مجموع قيمة حروف كلمة “ظلمه” (900 + 30 + 40 + 5 = 975 هـ!!).
نقط سوداء- حمراء
العرب كانوا يعتبرون نقط الكتاب أو شكله سوء ظن بالمكتوب إليه!، ولكن ضرورة المحافظة على القرآن من اللحن والتصحيف، بعد الفتوح، ودخول غير العرب في الإسلام، شجعت المتحمسين لوقاية كتاب الله، على اختراع الشكل ووضع النقط، فإن خلو المصاحف منهما نتج عنه اختلاف في القراءات، فقد قرئت الآية {يزيد في الخلق ما يشاء} يزيد في الحلق ما يشاء! وقرئت {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها} أمّرنا مترفيها!
وكانت أولى الخطوات لتوجيه النطق الصحيح هي وضع علامات التشكيل، بدأ ذلك في سنة (69 هـ)، في بداية العصر الأموي، بالنظام الذي وضعه “أبو الأسود الدؤلي”. ويحكى أن “زياد” والي البصرة طلب من “أبي الأسود” أن يضع شيئاً يضمن القراءة الصحيحة لكلام الله، فلما أبطأ أوعز زياد إلى رجل من أتباعه أن يقعد في طريق “أبي الأسود” فلما اقترب “أبوالأسود” رفع الرجل صوته، وقرأ: {إن الله بريء من المشركين ورسوله}، بكسر اللام في “رسوله” فاغتم “أبو الأسود” وقال: “عز وجه الله أن يبرأ من رسوله”. ورجع فوراً إلى “زياد”، وقال له: “قد أجبتك إلى ما سألت، ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن فاعطني كاتباً”. فبعث إليه زياد بثلاثين كاتباً، فاختار منهم واحداً وقال له: “خذ المصحف وصبغاً أحمر، فإذا رأيتني فتحت شفتي بالحرف فنقطة واحدة فوق الحرف، وإذا كسرتهما فنقطة واحدة أسفله، وإذا ضممتهما فاجعل النقطة بين يدي الحرف، فإن تبعت شيئاً من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين”. وأخذ “أبوالأسود” يقرأ القرآن متأنياً، والكاتب يضع النقط الحمراء، وكلما أتم الكاتب صفحة أعاد “أبو الأسود” نظره عليها حتى أعرب المصحف كله. ورغم هذا العمل الكبير الذي ضبط القراءة، إلى حد كبير فقد كان هناك التباس وغموض وقراءات خاطئة نتيجة لعدم التفريق بين الحروف المتشابهة مثل القاف و الفاء، أو الجيم والخاء والحاء، وظهرت ضرورة الإعجام؛ أي التفريق بين الحروف الواحدة بواسطة نقط مميزة لحرف عن آخر من الحروف، قام بهذه المهمة “يحيى بن يعمر” و”نصر بن عاصم” وكانا تلميذي “أبي الأسود”، وأصبحت النقطة جزءاً من الحرف.
أصبح النص مليئاً بالنقط السوداء والنقط الحمراء، وكان لابد أن يأتي من يفك الاشتباك، وفعلها “الخليل ابن أحمد”، في أوائل العصر العباسي، وضع مكان نقط الشكل الحمراء جرات علوية وسفلية للدلالة على الفتح والكسر وعبر عن الضمة برأس واو صغير، وعن السكون بدائرة كرأس الميم، وعن الشدة برأس “س” وعن الحرف المنون بتكرار العلامة. بهذا وصلت الكتابة العربية إلى شكلها النهائي، يقودها القرآن، إلى أطراف الأرض الوسيعة.
قلم
الأقلام العربية الكلاسيكية ستة، ومن هنا كانت التسمية “شش قلم”، والقلم يعني الخط، وهذه الخطوط الستة هي: الكوفي – الثلث – النسخ – الفارسي – الديواني – الرقعة، قلنا إن “قطبة” هو الذي اخترع قلم. “الجليل الشامي” أي القلم الذي مقياسه 24 شعرة وتطورت عنه باقي الأقلام.
فقلم الثلثين أي “16 شعرة” استخدم في كتابة السجلات، وقلم النصف أي “12 شعرة” استخدم في مراسلات الأمراء، وأما قلم صغير الثلث أي “8 شعرات” فهو قلم الرقاع.
وفي البلاغة لكل مقام مقال، وهذه أيضاً بلاغة الخط فلكل قلم “خط” مقال! هناك خط للسلطان، وهناك خط للعامة، فالخط اللين المدور، استعمل في تدوين عقود البيع والشراء والمراسلات وكل ما يقتضي السرعة في التدوين، واليد المسرعة لا تستطيع الحفاظ على استقامة الخطوط والزوايا، فهي تكتب خطاً تطغى عليه الليونة والاستدارة. يقول “الحافظ عثمان” -الخطاط التركي الشهير-: “لو عرضت عليّ الخطوط المختلفة التي أكتبها في بحر الأسبوع، لعرفت من بينها خطوط يوم السبت”! كيف؟!. يستمر الحافظ ” لأنها تكون أقل مرونة من خطوط بقية الأيام، بسبب توقفي عن الكتابة يوم الجمعة”.
لعلك عرفت، كما عرفت أنا لماذا يشيع خط النسخ في الكتب والمجلات والصحف، ولماذا أصبح خط الرقعة لبساطته واختزاليته هو الخط الذي يشيع في حياتنا اليومية، نكتب به رسائلنا، ومذكراتنا ومحاضراتنا، ويدون به الموظفون المعاملات الرسمية في سجلاتهم منذ اختراعه وحتى الآن. بل ونفهم لماذا انسحب الخط الكوفي من ميدان الكتابة الاجتماعية، ورضي بأن يكون زاهداً، ناسكاً، قانعاً بسكنى المساجد والمحاريب، وزخرفة المصاحف، وعناوين الكتب.
سلاطين تلامذة
“ابن مقلة” أول الرواد الكبار في عالم الحرف العربي، وهو كاتب وأديب وخطاط، تولى الوزارة ثلاث مرات، هذا العبقري، انصرف إلى الخط الكوفي يدرسه ويطوره ويضبطه بقواعد ثابتة، واستطاع وحده، أن يرى الدائرة في المربع! ويخرج النسخ من الكوفي، فيستحسنه العرب لجماله وسهولة كتابته ووضوحه وليونته، فاعتمدوه لكتابة المصاحف. كان “ابن مقلة” وزير الخليفة العباسي “المقتدر”، وتولى الوزارة ثلاث مرات، آخرها أيام “الراضي” الذي اعتقل “ابن مقلة” في حجرة من دار الخلافة، ثم قطع الوزير “ابن رائق” يده، ورمى به في الحبس فأخذ ينوح على يده، وينشد:
إذا ما مات بعضك فابك بعضاً فإن البعض من بعض قريب
ولم يستسلم، وأخذ يمرن يده اليسرى حتى أجاد بها الخط، ولكن المصائب توالت، فقطع لسانه، ثم قتل ودفن في دار الخلافة، طلبه أهله فنبش قبره، وسلم إليهم فدفنوه، وطلبته زوجته فعادوا ونبشوا قبره ودفن في دارها. أما “ابن البواب” الرائد الثاني، الذي ابتدع خط “الريحاني” وخط “المحقق” فقد كان أبوه بواب دار القضاء في بغداد، وكان هو مزوقاً يصور الدور، ثم أخذ في تصوير الكتب وممارسة الكتابة وتجويد الخط، واهتم بجمع خطوط “ابن مقلة” في النسخ والثلث، وعكف عليها ينقحها ويضبطها حتى وصل بها إلى الكمال. وقد نظم قصيدة رائية ضمنها قواعد الخط من ثمانية وعشرين بيتاً بعدد حروف الهجاء بدأها:
يا من يريد إجادة التحرير ويروم حسن الخط والتصوير
أما ثالث الرواد الكبار فهو “ياقوت المستعصمي” وكان خازناً بدار الكتب المستنصرية وهو شاعر وأديب، بلغ في الخط من الجودة والإتقان ما جعله يفوق “ابن مقلة” و”ابن البواب”، وصارت كتابته في الثلث والنسخ الأساس الذي جرى عليه كبار الخطاطين، لذلك أسموه “قبلة الكتاب”.
هؤلاء هم الرواد الكبار الذين شكلوا أذواقنا في الخط وحببوا إلينا شكل الحروف. قال “النويري” يصف الخط الجميل: “يستحق الخط أن يوصف بالجودة، إذا اعتدلت أقسامه وطالت ألفه ولامه، واستقامت سطوره، وضاهى صعوده جذوره، وتفتحت عيونه ولم تشتبه راؤه ونونه..” وينتهي إلى هذه العبارة العبقرية الفاتنة “وخيل إليك أنه يتحرك وهو ساكن”!
وقد بلغ من احترام الأتراك للخط أن تتلمذ السلاطين على الخطاطين، فكل من السلطان “مصطفى خان” و”أحمد خان” تتلمذ على “الحافظ عثمان”، كما تتلمذ السلطان “محمود خان” على “مصطفى راقم”
مجلة العربي، العدد 418، سبتمبر 1993م